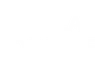الكلمة التاسعة
التنقل
41. صفحة
الكلمةُ التاسعة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
﴿فَسُبْحَٰنَ اللَهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ { وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾
(سورة الروم: ٣٠-١٧-١٨)
أيها الأخ؛ تسألني عن حِكمة تخصيص الصلاة في هذه الأوقات المُعَيَّنَةِ الخمسةِ؛ فسنشير إلى واحدة فقط من حِكمها الكثيرة جدًّا.
إن وقت كل صلاة بدايةُ انقلاب مهم، ومرآة تَصَرُّفٍ([1]) إلهيٍّ عظيمٍ، وعاكِسٌ([2]) للإحساناتِ الإلهيةِ الكليةِ في ثنايا ذلك التصرف؛ لذا فُرضَت الصلاةُ التي هي الإكثار من التسبيح والتعظيم للقدير ذي الجلال في تلك الأوقات، والشكرُ والحمد تجاه مجموع نِعمِهِ غيرِ المحدودة المجتمِعة بين وقتين.
ولفهم بعض ذلك المعنى العميق الدقيق ينبغي الاستماع مع نفسي إلى خمسِ نِكات.
النكتة الأولى: إن معنى الصلاة هو التسبيح والتعظيم والشكر للحق
تعالى؛ أي: تقديس جلالِهِ بـ “سبحان الله” قولاً وفعلاً، وتعظيم كمالِهِ
بـ“الله أكبر” لفظًا وعملاً، وشكر جمالِهِ بـ “الحمد لله” قلبًا ولسانًا وبدنًا.
إذن التسبيح والتكبير والحمد هي بمنزلة نَوى الصلاة؛ ولذلك توجد هذه الثلاثة في جميع حركات وأذكار الصلاة؛ ولذلك تُكَرَّرُ هذه الكلمات المباركة عقب الصلاة ثلاثًا وثلاثين مرة لتأكيد معنى الصلاة وتقويته، وتؤَكَّد بتلك الخلاصات المجملة.
[1] التصرّف: تدبير الأمور.
[2] عاكس للإحسانات: مرآة تنعكس فيها إحسانات الله عزّ وجلّ.
.
42. صفحة
النكتة الثانية: إن معنى العبادة هو سجود العبد بإعجاب وتقدير ومحبة بين يدي الحضرة الإلهية أمام كمال الربوبية والقدرة الصَّمَدَانِيَّةِ([1]) والرحمة الإلهية بإدراكه قصورَ نفسِهِ وعجزَهُ وفقرَهُ.
كما أن سلطنة الربوبية تقتضي العبوديةَ والطاعة؛ فإن قُدْسِيَّةَ الربوبية وطهارتَها تستلزم أن يعلن العبدُ - مع استغفاره بعدما وقف على تقصيره - أن ربّه منزّه ومُبَرَّأٌ([2]) من كل النقائص، ومنَزَّهٌ ومعلَّى عن الأفكار الباطلة لأهل الضلالة، ومقدَّس ومنَزَّه عن كل نقائص وقصورات الكائنات، مسبِّحًا قائلاً: “سبحان الله”.
وكذلك تتطلب القدرةُ الكاملة للربوبية أن يلتجئَ العبدُ إلى ربه ويتوكلَ عليه، وأن يركعَ بخضوع قائلاً: “الله أكبر” أمام عظمة آثار القدرة الصمدانية، باستحسان وإعجاب بعد إدراكه ضعفَه وعجزَ بقيةِ المخلوقاتِ.
وكذا تقتضي خزينة الرحمة اللانهائية للربوبية أن يُظهِر العبد احتياجَهُ واحتياجاتِ كلِّ المخلوقات وفقرَها بلسان السؤال والدعاء، وأن يعترف بإحسانِ ربِّه وإنعامِه بالشكر والثناء قائلاً: “الحمد لله”.
أي إن أفعالَ الصلاة وأقوالَها تتضمن هذه المعاني، وإنها وُضِعت لأجل تلك المعاني من قِبَل الله تعالى.
النكتة الثالثة: كما أن الإنسانَ مثالٌ مصغَّرٌ لهذا العالَمِ الكبير، وأن الفاتحة الشريفة مثالٌ منوَّر لهذا القرآن العظيم الشأن؛ فالصلاة كذلك فهرس نورانيٌّ شامل لجميع أنواع العبادات، وخريطةٌ قدسية تشير إلى ألوان العبادات لجميعِ أصناف المخلوقات.
النكتة الرابعة: كما أن عقاربَ ساعةٍ أسبوعية تَعُدُّ ثوانِيَها ودقائقَها وساعاتِها وأيامَها، تُناظِرُ بعضُها بعضًا، ويماثل كلٌّ منها الآخرَ، ويأخذُ كلٌّ منها حُكمَ الآخرِ؛ كذلك فإنَّ تعاقُبَ الليل والنهار الذي بحكم ثانية لهذا العالَم الدنيوي الذي هو ساعة كبرى لله تعالى، والسنواتِ التي تَعُدُّ الدقائقَ، وطبقاتِ عمر الإنسان التي تَعُدُّ الساعات، وأدوارَ
[1] الصمدانية: نسبةً إلى الصمد، وهو المقصود وحده في الحوائج والشدائد.
[2] مبَرَّأٌ: خالٍ من العيوب.
43. صفحة
عمر العالم التي تَعُدُّ الأيامَ؛ هي أيضًا يُناظِر بعضُها بعضًا، ويماثل كلٌّ منها الآخرَ، ويأخذ كل منها حُكمَ الآخَرِ ويُذَكِّرُ بعضُها ببعضها الآخر.
فمثلاً: وقت الفجر إلى طلوع الشمس يشبه ويُذكِّرُ ببدايةِ الربيع، وأوانِ سقوطِ الإنسانِ في رحم الأُمِّ، واليومِ الأولِ من أيام خَلْقِ السماوات والأرض الستِّ، وينبه على ما فيها من شئونٍ إلهية.
وأما وقت الظهر: فيشبه منتصَفَ فصل الصيف ويشير إليه وإلى الكمال الشبابي، وإلى فترة خَلْقِ الإنسان في عمر الدنيا، ويُذَكِّرُ بما فيها من تجليات([1]) الرحمة وفيوضات([2]) النعمة.
وأما وقت العصر: فَيُشبه فصلَ الخريف، ووقتَ الشيخوخةِ وعصرَ السعادة لنبيِّ آخِرِ الزمان عليه الصلاة والسلام، ويُذَكِّرُ بما فيه من شئون إلهية وإنعامات رحمانية.
أما وقت المغرب: فهو ينبه ويوقظ البشر من نوم الغفلة، ويُفَهِّمُهُم التجلياتِ الجلاليةَ بتذكيره بغروب مخلوقات كثيرة جدًّا في آخر فصل الخريف، وبتذكيره بوفاة الإنسان وبخراب الدنيا عند ابتداء القيامة.
أما وقت العِشَاء: فهو يعلن التصرفاتِ الجلاليةَ للقهَّارِ ذي الجلال بتذكيره سَتْرَ عالَمِ الظلماتِ بكَفَنِهِ الأسودِ آثار عالَم النهار، وبتذكيره تغطيةَ الشتاء بكفنه الأبيض وجهَ الأرض الميِّتة، وبتذكيره موتَ بقايا آثار الإنسان المتوفَّى ودخولَها تحت ستار النسيان، وبتذكيره انغلاقَ هذه الدنيا - التي هي دارُ الامتحان- نهائيًّا.
أما وقت الليل: فيُذَكِّر الإنسانَ مدى احتياج روح البشر إلى رحمة الرحمن بتذكيره الشتاءَ والقبرَ وعالَمَ البرزخ.
أما التهجد في الليل: فيُذَكِّر كم هو ضياء ضروري في ليل القبر وظلمات البرزخ، ويعلن في تلك الانقلاباتِ كلِّها مدى استحقاق المنعِمِ الحقيقي جلَّ وعَلا للحمد والثناء بتذكيره نِعمَهُ غيرَ المحدودة.
أما الصباح الثاني: فإنه يذكر بصباح الحشر. نعم؛ فكما أن صباح هذه الليلة وربيعَ هذا الشتاء معقول وضروري وقطعيّ؛ فإن صباحَ الحشر وربيعَ البرزخ كذلك معقولٌ وضروري وقطعيّ مثلُه.
[1] تجليات الرحمة: تجلَّى الشيءُ أي انكشف وظهر، وتجليات الرحمة هنا يعني ظهورها وانكشافها.
[2] فيوضات: جمع فيوض، وفيوض جمع فيض، والفيض هو الكثير والغزير، ويُقصَد هنا العطاء الغزير من الإنعامات والإكرامات الإلهية.
44. صفحة
إذن فكما أن كلَّ وقتٍ من تلك الأوقات الخمسة هو رأسُ انقلابٍ مهم وكما أنه يذكِّر بانقلابات عظيمة؛ كذلك فإنه يذكِّر بمعجزات القدرة وهدايا الرحمة السنوية والعصرية والدهرية بإشارة التصرفات العظيمة اليومية للقدرة الصمدانية.
إذن فالصلوات المفروضة - والتي هي وظيفةُ الفطرة الأصلية وأساس العبودية والدِّيْن الخالص - لائقةٌ ومناسِبةٌ جدًّا في هذه الأوقات.
النكتة الخامسة: إن الإنسانَ ضعيفٌ جدًّا بفطرته مع أن كل شيء يزعجه ويُؤَثِّر فيه ويؤلمه، وهو عاجز جدًّا مع أن مصائبه وأعداءه كثيرون جدًّا، وهو فقير جدًّا مع أن احتياجاتِهِ كثيرةٌ للغاية، وهو كسول وغير مقتدر مع أن تكاليفَ حياته ثقيلةٌ جدًّا، وإن الإنسانية جعلَتْه ذا علاقة بالكون مع أن زوال وفراق الأشياء التي يحبها ويأنس بها يؤلمه ويزعجه دومًا وباستمرار، وإن العقل يريه مقاصدَ عاليةً وثمارًا باقيةً مع أن يدَهُ قصيرةٌ وعمرَه قصيرٌ واقتدارَهُ ضئيل وصبرَه قليلٌ.
فروحٌ هذا شأنُها وحالها؛ يُفهَم بداهةً كم هو ضروريٌّ عَرْضُ حالِها على ديوان القدير ذي الجلال والرحيم ذي الجمال، طارِقةً بابَه بالتضرع والصلاة في وقت الفجر، وطلَبُها منه التوفيقَ والمددَ؛ وكم أن ذلك نقطةُ استناد ضروريةٌ لتَحَمُّلِ ما سيصيبُها وما سيُحْمَل على عاتقها من الأمور والوظائف في عالَم النهار الذي يعقب ذلك الفجر.
ووقت الظهر الذي هو وقت كمالِ النهار وابتداء زواله، وهو أوان اكتمال الأمور اليومية، وهو زمن استراحة مؤقتة من مضايقة المشاغل وإزعاجِها، وهو وقت احتياج الروح إلى الاسترواح([1]) والتنفس من الغفلة والْحَيرة والاضطراب الذي تُخَلِّفه الدنيا الفانيةُ والأمورُ الزائلة الثقيلة المرهِقة، والذي هو أوان ظهور الإنعامات الإلهية([2])، وأداء صلاة الظهر الذي يعني استعانةَ روح البشر وحمدها وشكرها على مجموع نِعَمِ المنعم الحقيقي والقيوم الباقي مكتوفةَ اليدين باللجوء إلى ديوانه بعد تخلصها من تلك المضايقاتِ وتجرُّدِها من تلك الغفلة وخروجِها من تلك الأمور الزائلة التافهة، وإظهارِ عجزِها بالركوع تجاه عظمته وجلاله جلَّ وعلا، وإعلانِ إعجابها ومحبتها وفنائِها بالسجود أمامَ كماله الذي لا زوال له وجمالِه الذي لا مثيل له؛ نقول: الإنسان الذي لا يدرك كم هو لطيف وكم هو ضروري وكم هو مناسب أداء صلاة الظهر - بتلك المعاني المذكورة - ليس بإنسان.
[1] الاسترواح: طلب الراحة.
[2] الإنعامات الإلهية: العطاءات الإلهية.
.
45. صفحة
وأما وقت العصر فيوحي بفصل الخريف الحزين، والشيخوخة المحزنة والموسمِ الأليمِ لآخِرِ الزمان وهو زمن انتهاءِ الأمور اليوميةِ ووقتُ تشكُّلِ المجموع العظيم للنِّعَم الإلهية التي نالها الإنسان في ذلك اليوم؛ كالصحة والسلامة والأعمالِ الخيِّرة، وهو وقتٌ يعلن - بإشارةِ ميل تلك الشمسِ الضخمة الهائلة إلى الأفول([1]) - أن الإنسانَ ضيفٌ ذو وظائف، وأن كلَّ شيء مؤقَّتٌ زائل غيرُ مستقِرٍّ.
ومن هنا فروح الإنسان التي تَنْشُدُ([2]) الأبدَ والتي خُلِقت للأبد، والتي تحب الإحسان إلى درجة العبودية وتتألم من الفراق؛ تقوم إذن فتتوضأ في وقت العصر لأداء صلاة العصر عارضةً مناجاتِها([3]) في ديوانٍ صمدانيٍّ للقديم الباقي والقيوم السَّرْمَدِيِّ([4]) وحامدةً وشاكرة نِعمَه التي لا تُعَدُّ ولا تُحصى ملتجئةً إلى اِلتفات رحمته التي لا زوال لها ولا نهاية، وتنزل إلى الركوع متذلِّلَةً أمام عزة ربوبيته وساجدةً بفناءٍ أمامَ سرْمَدِيَّة ألوهيته؛ فتجد تسْلِيَةً حقيقيةً وراحةً للروح بوقوفها بعبودية تامة في حضرة كبريائه.
فأداء صلاة العصر التي تفيد كلَّ ذلك، يَفهم منها من كان إنسانًا حقًّا كم هي وظيفةٌ علويةٌ، وكم هي خدمة مناسبة، وكم هي أداءٌ في محله لِدَيْنِ الفطرة بل فوز بسعادة في غاية اللطافة.
أما وقت المغرب فهو زمن يوحي بوقت غروب مخلوقات عالَمَي الصيفِ والخريف الرقيقة اللطيفة الجميلة في وداعها الحزين عند بداية الشتاء، ويُذَكِّرُ كذلك بزمن دخول الإنسان القبرَ عند وفاته وفراقه الأليم لكل أحبائه، ويذكر كذلك بزمن رحيل سكان هذه الدنيا كلِّهم إلى عوالِمَ أخرى بوفاة هذه الدنيا وزلزلتها في سكراتها، ويذكِّر بزمن انطفاء مصباح دار الامتحان هذه، وهو زمانٌ يوقظ بشدةٍ أولئك الذين يحبون المحبوبات التي تغرب في الزوال بدرجة العبودية.
فروح البشر التي هي مرآة مشتاقة بفطرتها لجمالٍ باقٍ والتي تتوجه لصلاة المغرب في وقت كهذا؛ تُوجِّه وجهَها إلى عرش عظمة القديم الذي لَم يَزَلْ، والباقي الذي لا يزال، والذي يقوم بهذه الأمور العظيمة ويدبر ويبدل هذه العوالمَ الجسيمةَ، قَائلة:
[1] الأفول: الغروب والغياب.
[2] تَنْشُدُ: تطلب.
[3] مناجاتها: دعاؤها في سِرِّها.
[4] السرمديّ: الأبديّ.
46. صفحة
“الله أكبر” فوق هذه الفانيات، فتَنْفُضُ يديها([1]) منها وتربطها مُتَأَهِّبَةً([2]) لخِدمة المولى وتقوم في حضرة الدائم الباقي، وتحمَده وتُثنِي عليه بقولها: “الحمد لله” على كماله الذي لا قصور فيه، وعلى جماله الذي لا مثيل له، وعلى رحمته التي لا نهاية لها، وتستعين به وتقدم عبوديتها بقولها: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (سورة الفاتحة: ١-٥) أمام ربوبيته التي لا مُعين لها، وألوهيته التي لا شريك لها، وسلطنته التي لا وزير لها، فتركع أمام كبريائه الذي لا نهاية له وقدرته التي لا حد لها، وعزته التي لا عجز فيها، بإظهار ضعفها وعجزها وفقرها وذُلِّها مع كل الكائنات قائلة: “سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ” فتُسبِّح ربَّها العظيمَ.
وكذا تسجد أمام جمال ذاته الذي لا زوال له، وصفاتِ قدسيته التي لا تغيُّر فيها، وكمالِ سرمديته([3]) الذي لا تبدُّل فيه، وتعلن محبّتَها وعبوديتها بترك ما سواهُ تعالى في إعجاب وفناء، وتجد جميلاً باقيًا ورحيمًا سرمديًّا بدلاً من كل الفانياتِ، وتُقدِّسُ ربَّها الأعلى المنَزَّهَ عن الزوال والمبرّأَ من العيوب والنقائص بقولها: “سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى”.. ثم تجلس للتشهد فتُهدي التحياتِ المباركةَ لجميع المخلوقات، وصلواتها الطيبات باسمها وبحسابها إلى الجميل الذي لَم يزلْ والجليل الذي لا يزال، وتُظهِر إطاعةَ أوامِرِه بالسلام على رسوله الأكرم عليه الصلاة والسلام وبتجديد بيعتها له، وتشهد لوحدانية الصانع ذي الجلال بمشاهدتها الانتظامَ الحكيمَ لقَصْرِ الكون هذا بُغيَةَ تنوير إيمانها بالتجديد، وتشهد على رسالة محمد العربي عليه الصلاة والسلام الذي هو داعٍ لسلطنة الربوبية ومبلَِّغُ مرضياتِه تعالى، وترجُمانُ([4]) آياتِ كتابِ الكونِ.
فانظر كيف أن أداء صلاة المغرب - الذي يحمل كل تلك المعاني المذكورة - وظيفةٌ لطيفةٌ نظيفة، وكم هو خدمة عزيزة لذيذة، وكم هو عبودية طيبة جميلة، وكم هو حقيقة جِدُّ مهمة، وأنه صحبة باقية وسعادة دائمة في دار الضيافة الفانية هذه!!
فكيف يكون الإنسان إنسانًا إن لم يدرك هذا ويشَعُر به؟!
أما وقت العِشاء: فهو وقت تَغِيب فيه تلك البقيةُ الباقيةُ كذلك في الأفق من آثار
[1] تَنْفُضُ يديها من الشيء: تمتنع عن الاستمرار فيه.
[2] تربطها متأهِّبَةً: أي تضع كفًّا على كفٍّ كما يفعل المصلّي في الصلاة، ومتأهبة مستعدّة.
[3] سَرْمَدِيَّته: أبديّته.
[4] ترْجُمَانُ القرآن: مفسِّره وناقل معانيه.
47. صفحة
النهار، ويخيم([1]) عالَمُ الليل على الكون، وهو زمان يُذَكِّرُ بالتصرفات الربانية للقدير ذي الجلال الذي هو مُقَلِّبُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ في تحويله تلك الصحيفةَ البيضاءَ إلى هذه الصحيفةِ السوداءِ، ويُذَكِّر بالإجراءات الإلهية للحكيم ذي الكمال الذي هو مُسَخِّرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، في تحويله صحيفةَ الصيفِ المزينةَ الخضراءَ إلى صحيفة الشتاء الباردةِ البيضاء، ويُوحي بالشئون الإلهية لِخَالِقِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ في انتقال بقيةِ آثار أهل القبور مع مرور الزمان إلى عالَمٍ آخَرَ كليًّا بانقطاعها عن هذه الدنيا.
وهو زمانٌ يوحي ويُذكِّر بالتصرفات الجلالية والتجليات الجمالية لِخَالِقِ الأرضِ وَالسَّمَاوَاتِ في انكشاف عالم الآخرة الواسعِ الأبدي العظيم بعد السكرات العظيمة لوفاة الدنيا الضيقة الفانية الحقيرة، وخرابها تمامًا، وهي- حالٌ تثبت أن المالكَ والمتصرفَ الحقيقيَّ في هذا الكون والمعبودَ والمحبوبَ الحقيقيَّ له إنما هو ذاتٌ قادرٌ مطلقٌ، يقلِّب الليلَ والنهارَ والشتاءَ والصيفَ والدنيا والآخرةَ بسهولةٍ كسهولةِ تقليبِ صحائفِ كتابٍ، ويكتبها ويمحوها ويغيرها ويبدلها ويحكم عليها كلِّها.
فروح البشر التي هي في عجزٍ وضعف لا نهاية لهما، والتي هي في فقر واحتياج لا حد لهما، والتي تقتحم ظلماتٍ لا حدود لها للمستقبل، والتي تضطرب وتتقلب في حادثاتٍ لا نهاية لها؛ فهذه الروح حين تؤدي صلاة العشاء بهذا المعنى في وقت العِشاء هذا فإنها تقول كإبراهيم عليه السلام:
﴿لآَ أُحِبُّ الأَفِلِينَ ([2])﴾ (سورة الأنعام: ٦-٧٦) وتلتجئ بالصلاة إلى ديوان معبود لم يزل ومحبوب لا يزالُ، وتناجِي الباقيَ السرمديَّ في هذا العالَم الفاني والعمرِ الفاني، وفي هذه الدنيا المظلمة، وفي هذا المستقبلِ الْمُعْتِمِ، وترى وتطلب اِلْتِفاتاتِ([3]) رحمةِ ونورِ هدايةِ الرحمن الرحيم الذي ينثر النور في دنياها من خلال جزء يسير من صحبةٍ باقيةٍ ودقائقَ معدودة في عمر باقٍ، والذي يضيء مستقبلها، والذي يُضَمِّدُ([4]) جروحها الناشئةَ عن فراق أحبابها وفراق وزوال كل الموجودات، وتنسى هي الأخرى مؤقتاً الدنيا التي نسيَتْها واختفت عنها،
[1] يُخَيِّمُ: يَغشى ويُغَطِّي.
[2] الآفلين: الغائبين.
[3] التفاتاتُ رحمة: إكرامات وإنعامات وألطاف الرحمة.
[4] يُضَمِّدُ: يعالج.
48. صفحة
وتَبُثُّ همومَها وأحزانها أمام ديوان الرحمة ببكاء قلبها.
وتوقُّعًا لأي احتمال تؤدي وظيفة عبوديتها النهائيةَ قبل وُلُوجِها([1]) في النوم الذي يشبه الموت، فتقوم لأداء الصلاة لإغلاق دفتر أعمالها اليوميةِ بحسن الخاتمة أي: المثول([2]) بين يدي معبود ومحبوب باق بدلاً من كل محبوباتها الفانيةِ، وبين يدي قدير كريم بدلاً من كل العَجَزةِ الذين تتسول لديهم، وبين يدي حفيظ رحيم للتخلص من شرور كل المخلوقات المضرة التي ترتجف أمامها، فتستهل بالفاتحة؛ أي: تمدح وتُثْنِي على رب العالمين الذي هو كامل مطلق، وغني مطلق بدلاً من مدحٍ وامتنانٍ - لا طائل وراءهما وغيرِ مناسبين - لمخلوقات ناقصة فقيرة.
ثم هي ترتقي إلى خطاب: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ أي تدخل مقامَ ضيفٍ مكرَّمٍ وموظَّف مهم في هذا الكون بانتسابها إلى مالك يوم الدين الذي هو سلطان الأزل والأبد على الرغم من صغرها ومَعْدُومِيَّتِهَا([3]) ووحشتها؛ فتتقدم إليه بعبادات واستعانات جماعة الكون الكبرى وجمعيته العظمى - باسم جميع المخلوقات - قائلة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، ثم تطلب الهدايةَ إلى الصراط المستقيم الذي هو طريقه النوراني والذي يمتد إلى السعادة الأبدية في ظلمات المستقبل قائلة:
﴿اهْدِنَا الصِّرَٰطَ المُستَقِيمَ﴾ (سورة الفاتحة: ١-٦)
ثم تنزل إلى الركوع قائلة: “الله أكبر” بالتفكر في كبرياء الذَّات ذي الجلالِ، الخاضِعِ لسلطانِ أوامِره - كالجندي - كلُّ النباتات والحيوانات المستغْرِقةِ في نومها، وكُلُّ الشموسِ المختفيةِ، والنجومِ الساهرةِ الآن التي هي مصابيحُ وخدمٌ له في هذا العالم دارِ الضيافة.
ثم تتفكر في السجدة الكبرى لجميع المخلوقات؛ أي أنواع الموجودات، بما فيها الأرض والدنيا في كل سنة وفي كل عصر - كالمخلوقات النائمة في هذه الليلة - تسجد كجيش منظم بل كجندي مطيع بانتظام كامل قائلة: “الله أكبر” في سجادة الغروب([4]) في وقت الزوال حينما تُسرَّح بأمر “كن فيكون” من وظيفة عبوديتها الدنيوية؛ أي: حينما تُبعَث إلى عالم الغيب وكذا يُبعَث ويُحشَر قسمٌ منها - المخلوقات - بعينه وقسم بمثله
[1] ولوجها: دخولها.
[2] المثول بين يديه: الوقوف.
[3] معدوميّتها: أي عدم وجودها وانعدامها.
[4] سجادة الغروب: تصوير للغروب في جمال منظره بسجادة.
ه
49. صفحة
مرة أخرى في الربيع بصيحة إحياءٍ وإيقاظٍ منبعثة من أمر “كن فيكون” فتقوم متأهِّبة مستعدة لخدمة المولى؛ فكذلك يسجد هذا الإنسان (الصغير) المسكين الضعيف الفقير قائلاً: “الله أكبر” اقتداءً بها في ديوان حضرة الرحمن ذي الكمال، والرحيم ذي الجمال، بمحبة مُفْعَمَةٍ([1]) بالإعجاب، وبفناءٍ مُفْعَمٍ بالبقاء، وبتذلل مفعم بالعِزِّ.
ولا شك أنك قد فهمتَ كم هو لطيف وجميل أداء صلاة العشاء الذي هو نوع من المعراج ، وكم هو حُلْوٌ وسَامٍ([2]) وكم هو عزيز ولذيذ، وكم هو وظيفة وخدمة وعبودية وحقيقة جِدُّ مهمة معقولة ومناسبة.
إذن ولأن كل وقت من هذه الأوقات الخمس هو إشاراتٌ لانقلابٍ عظيم، وأماراتٌ للإجراءات الجسيمة الربانية، وعلاماتٌ للإنعامات الإلهية الكليِّة؛ فتخصيص الصلوات المفروضة التي هي دَيْنٌ وذِمَّةٌ في تلك الأوقات هو منتهى الحكمة.
سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحْكِيمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أَرْسَلْتَهُ مُعَلِّمًا لِعِبَادِكَ لِيُعَلِّمَهُمْ كَيْفِيَّةَ مَعْرِفَتِكَ وَالْعُبُودِيَّةَ لَكَ وَمُعَرِّفًا لِكُنُوزِ أَسْمَائِكَ، وَتُرْجُمَانًا لآيَاتِ كِتَابِ كَائِنَاتِكَ وَمِرْآةً بِعُبُودِيَّتِهِ لِجَمَالِ رُبُوبِيَّتِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَارْحَمْنَا وَارْحَمِ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ..
آمِينَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ..
[1] مُفْعَم: مَلآنٌ.
[2] سامٍ: عالٍ وراقٍ ومرتفِع.
جدول المحتويات
جدول المحتويات