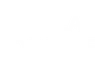اللمعة الأولى
التنقل
1. صفحة
اللمعة الأولى
من "المكتوب الحادي والثلاثين"
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء:87)
﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (الأنبياء:83)
﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (التوبة:129)
﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران:173)
لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي
القسم الأول من "المكتوب الحادي والثلاثين" عبارة عن "ست لمعات" تبيِّن نورًا من الأنوار الكثيرة لكل كلمة من الكلمات المباركة المذكورة أعلاه، تلك الكلمات التي لقراءتها ثلاثًا وثلاثين مرةً كل حين -وبخاصة بين المغرب والعشاء- فضائلُ كثيرةٌ.
2. صفحة
اللمعة الأولى
إن مناجاة سيدنا يونس بن مَتَّ -على نبيِّنا وعليه الصلاة والسلام- من أعظم المناجاة، وأهم وسيلة لإجابة الدعاء.
وخلاصة قصة سيدنا يونس عليه السلام المشهورة هي أنه قد أُلقي به في البحر، فالتقمه الحوت، وكان البحر هائجًا مائجًا، والليل مضطربًا ومظلمًا، وكان الأمل منقطعًا من كل جهة، وبينما هو في هذه الحالة ناجى ربه قائلاً ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ وإذا بمناجاته أصبحت واسطة نجاة له.
والسر العظيم لهذه المناجاة هو أن الأسباب قد سقطت كليًّا في تلك الحالة؛ وذلك أن الذي يستطيع أن ينجيه وينقذه من تلك الحالة ليس إلا مَن ينفذ حكمُه في الحوت وفي البحر وفي الليل وفي جو السماء؛ لأن الليل والبحر والحوت قد اجتمعت عليه، فلا يستطيع أن يوصله إلى بر الأمان إلا من يستطيع أن يُسَخِّرَ هذه الثلاثةَ كلَّها معًا تحت أمره.
فحتى لو كان جميع الخلق خُدّامًا له -عليه السلام- ما نفعوه شروى نقير، بمعنى أنه لا تأثير لـ"الأسباب".
وقد رأى -عليه السلام- بعين اليقين أنه لا ملجأ إلاَّ إلى "مسبِّب الأسباب"، فانكشف له سرّ "الأحدية" في نور "التوحيد"، فسخَّرت له هذه المناجاةُ فجأة الليلَ والبحرَ والحوتَ معًا، وجعلت بطن الحوت بنور التوحيد كغواصة، وجعلت البحر المضطرب بالأمواج الهائلة كالجبال المتزلزلة كصحراءَ آمنة ومتنَزّهٍ هادئٍ للتجوالِ بنورِ التوحيدِ هذا، وكشفت بهذا النور الغيومَ عن وجه السماء، وجعلت القمر فوق رأسه كالمصباح، وكشفت له وجهَ الصداقة في كل جهةٍ هذه المخلوقاتُ المرعبة التي تهدده وتُضَيِّقُ عليه الخناقَ، حتى وصل إلى بَرِّ الأمان، وشاهدَ ذلك اللُّطْفَ الربانيَّ تحت شجرة اليقطين.
3. صفحة
فنحن في وضع رهيب أشد من الحالة الأولى لسيدنا يونس عليه السلام بمائة درجة؛ فلَيْلُنا هو المستقبل، ومستقبلنا بنظر الغفلة أشد ظلامًا ورعبًا من ليله بمائة درجة.
وبحرنا هو كرتنا الأرضية التي تدور حائرةً؛ حيث إنه في كل موجة من أمواجِ هذا البحر آلاف من الجنائز، وهو أشد رعبًا من بحره هو بألف درجة.
وأما أهواء أنفسنا فهي حوتنا؛ إذ تسعى لتضييق حياتنا الأبدية ودمارها، وهذا الحوت أشد ضررًا من حوته بألف درجة؛ لأن حوته يقضي على حياة مدتها مائة سنة، وأما حوتنا نحن فيحاول أن يقضي على حياتنا التي تمتد مئات الملايين من السنين.
فبما أن حالتنا الحقيقية هكذا، فينبغي أن نقتديَ بسيدنا يونس عليه السلام، ونُعرِض عن "الأسباب" جميعها، ونلتجئ مباشرة إلى ربنا وحده الذي هو "مسبب الأسباب" قائلين:
﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، ويجب أن ندرك بعين اليقين أن الذي يمكنه أن يدفع عنا ضرر ما اجتمع علينا بسبب غفلتنا وضلالنا من مستقبل ودنيا وهوى نفس ليس إلاَّ مَن كان المستقبل تحت أمره، والدنيا تحت حكمه، ونفوسنا تحت إدارته.
فأي سبب غير خالق السماوات والأرض يطّلع على أخفى وأدق خواطر قلوبنا، وينير لنا المستقبلَ بإيجاد الآخرة، ويُنقذنا من بين مئات الآلاف من أمواج الدنيا الخانقة؟ لا شيء بأية حال من الأحوال غير واجب الوجود يستطيع الإمداد والإغاثة دون إرادته وإذنه، وحاشا أن يكون غيره مخلِّصًا.
وما دامت حقيقة الحال هكذا، فكما أن الحوت أصبح مَرْكبًا وغواصة نتيجةَ هذه المناجاة، والبحر كصحراء جميلة ولطيفة، والليل رقيقًا لطيفًا مُقْمِرًا، فينبغي لنا نحن أيضًا أن نقول بِسِرِّ هذه المناجاة ﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، ويجب أن نجلب نظر رحمته سبحانه إلى مستقبلنا بجملة ﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ﴾، وإلى دنيانا بكلمة ﴿سُبْحَانَكَ﴾ وإلى نفوسنا بكلام ﴿إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾
4. صفحة
حتى يتنور مستقبلنا بنور الإيمان وبضياء بدر القرآن، وينقلبَ رعب ليلتنا ووحشتها إلى الأنس والتنزه، وندخلَ في حقيقة الإسلام التي هي كسفينة معنوية صُنِعت في معمل القرآن الحكيم في بحر دنيانا، وفي كرتنا الأرضية التي تُلقى فيها جنائز لا حدَّ لها بسبب مناوبة الموت والحياة باستمرار إلى العدم بعد ركوبها فوق أمواج السنوات والقرون، فنتجول في هذا البحر بسلام، ونصل إلى بر الأمان، وتنتهي بذلك وظيفة حياتنا، وتُنشِّط عواصفُ هذا البحر واضطراباتُه بتجديدها مناظر التنزه كتجدد شاشات السينما نظرَ العبرة والتفكُّر، وتلاطفه وتضيئه بدلاً من أن تثير الوحشة والدهشة، وحتى تكونَ نفوسنا الأمّارة بالسوء بسر القرآن هذا والتربية الفرقانية هذه مراكبَ لنا نركبها نحن ولا تركبنا هي، وتصبحَ وسيلةً قويةً للفوز بحياتنا الأبدية.
الحاصل:
كما أن الإنسان -باعتبار ماهيته الجامعة- يتألم من الحمَّى؛ فكذلك يتألم من زلازل الأرض واهتزازاتها، ومن الزلزال الأعظم للكون عند القيامة، وكما أنه يخاف من جرثومة صغيرة لا تُرَى إلا بالمجهر؛ يخاف كذلك من المذنَّب الذي يظهر من بين الأجرام العلوية السماوية، وكما أنه يحب بيته؛ فكذلك يحب الدنيا الكبيرة، وكما أنه يحب حديقته الصغيرة؛ فكذلك يحب الجنة الأبدية التي لا يحدها الحد باشتياق شديد، فلا يمكن أن يكون ربًّا ومعبودًا وملجأً ومخلِّصًا ومقصودًا لمثل هذا لإنسان إلا من يمسك الكون كله بيد تصرفه، والذرات والسيارات تحت أمره، ولابد أن مثل هذا الإنسان يحتاج دائمًا إلى أن يقول ﴿لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ مثلما قالها يونس عليه السلام.
سُبْحَانَكَ لاَّ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ