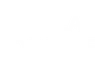اللمعة الثانية
التنقل
5. صفحة
اللمعة الثانية
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (الأنبياء:83)
هذه المناجاة لسيدنا أيوب عليه السلام -الذي هو بطل الصبر- مجرَّبَةٌ ومؤثِّرة جدًّا، فيجب علينا أن نقول في مناجاتنا مقتبسين من الآية: "رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".
وخلاصة قصة سيدنا أيوب عليه السلام المشهورة كالآتي:
لقد ظل يعاني أيوب عليه السلام من الجروح والقروح مدة طويلة؛ إلا أنه قد تحمل ذلك المرض بكامل الصبر مفكرًا في عظيم ثوابه، فلما أصابت الديدان الناشئة عن جروحه قلبَه ولسانَه، قال -ليس من أجل راحته بل مفكرًا في ألا يصيب خللٌ عبادتَه التي يقوم بها بقلبه ولسانه اللذين هما محل ذكر الله والمعرفة الإلهية- مناجيًا: "رب إني مسني الضر، وهو يُخِلّ بذكر لساني وعبادة قلبي"، فاستجاب الله تعالى لتلك المناجاة الخالصة البريئة والزكية والبعيدة عن الشوائب استجابة خارقة لا مثيل لها، ومنّ عليه بعافية كاملة، وأسبغ عليه أنواع رحمته، وفي هذه اللمعة "خمس نكات":
النكتة الأولى: إن فينا أمراضًا باطنية وروحية وقلبية مقابل جروح سيدنا أيوب عليه السلام وأمراضه الظاهرية، فلو انقلب باطننا إلى ظاهرٍ، وظاهرنا إلى باطنٍ؛ لظهر أننا مصابون بجروح وأمراض أكثر مما عند سيدنا أيوب عليه السلام؛ لأن كل إثم اقترفناه، وكل شبهة دخلت في ذهننا، يشقان جروحًا في قلوبنا وأرواحنا دائمًا.
6. صفحة
كانت جروح سيدنا أيوب عليه السلام تهدد حياته الدنيوية القصيرة فقط، أما جروحنا المعنوية فتهدد حياتنا الأبدية المديدة، إذن فنحن محتاجون أشد الاحتياج إلى تلك المناجاة الأيوبية أكثر من سيدنا أيوب عليه السلام بألف مرة، فكما أن الديدان الناشئة عن جروح سيدنا أيوب أصابت قلبه ولسانه؛ فكذلك الجروح الناشئة عن ذنوبنا وآثامنا، والوساوس والشبهات المتولدة عن تلك الجروحِ تصيبُ -والعياذُ بالله- باطنَ قلوبنا التي هي محل الإيمان، فتُخِل بإيماننا وتخدشه، وتصيب الذوقَ الروحاني للسانِ الذي هو ترجمان الإيمانِ، فتُنَفِّره عن الذكر، وتبعده عنه وتسكته.
أجل؛ الإثم يتوغل في القلب، وينفذ فيه، ويُسوّده دوما وباستمرار، فيُقسِّيه إلى أن يُخرِج نور الإيمان منه.
إن في كل إثم طريقًا يؤدي إلى الكفر، وإن لم يُمحَ ذلك الإثم بسرعة بالاستغفار يُصْبِحْ دودةً، بل حيّةًّ معنوية صغيرة تَعضّ القلب، فمثلا: إن الذي يرتكب -سرًّا- إثمًا مخجلا، ويخجل كثيرًا
من اطّلاع الآخرين عليه يثقل عليه، وجود الملائكة والروحانيات كثيرًا، ويرغب في إنكار وجودهم ولو بأمَارة صغيرة.
ومثلا: إن الذي يقترف كبيرة تُنتِج عذاب جهنم، إن لم يتحصن تجاهها بالاستغفار؛ فإنه كلما سمع تهديدات جهنم رغب في عدم وجودها بكل روحه، فتبعث شبهةٌ أو أمارة صغيرة في نفسه الجرأةَ على إنكار وجود جهنم.
ومثلا: إن الذي لا يقيم الصلوات المكتوبة، ولا يؤدي وظيفة العبودية، ويتألم من توبيخ مديره أو آمره الصغير بسبب تقصيره في أداء وظيفته، يُزعجه تكاسله عن أداء الفرائض تجاه أوامر سلطان الأزل والأبد المكررة إزعاجًا شديدًا، وبسبب هذا الانزعاج يرغب في عدم وجود وظيفة العبودية هذه، ويقول في سره "ليتها لم تكن"، فمن هذه الرغبة تستيقظ في نفسه رغبةُ إنكارٍ تُشمّ منها رائحة عداوة معنوية لله تعالى، وإذا وردت إلى القلب شبهة في وجود الله مالَ إلى التمسك بها، وكأنها دليل قاطع، فينفتح له باب هلاك عظيم.
7. صفحة
ولا يدرك هذا الشقي أنه يعرض نفسه بهذا الإنكار لضيق معنوي أشد بملايين بل بلايين المرات من ذلك الضيق الجزئي الضئيل الناشئ عن وظيفة العبودية، ويفر من لسع بعوضة إلى قبول عض الثعابين.
وهكذا فَلْتُتَّخَذْ هذه الأمثلة مقياسًا حتى يَتّضِح ويُفهَم سرّ ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (المطففين:14).
النكتة الثانية: ليس للإنسان حق الشكوى من المصائب والأمراض بـ"ثلاثة وجوه" كما بُيِّن في مبحث سرّ القدر في "الكلمة السادسة والعشرين".
الوجه الأول: إن الله تعالى قد جعل لباس الجسم الذي ألبسه للإنسان موضع ظهور صنعته وإبداعه؛ أي إنه جعل الإنسان نموذجاً، يُفَصِّلُ عليه لباسَ الوجود، ويَقُصُّه ويبدّله ويُغيّره، وبذلك يُظهِر ويري تجليات أسمائه المختلفة، فكما أن اسم "الشافي" يتطلب المرض، فاسم "الرزّاق" كذلك يقتضي الجوعَ، وهكذا "مَالِكُ المُلْكِ يَتَصَرّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ ".
الوجه الثاني: إن الحياة تصفو بالمصائب والأمراض، وبها تبلغ الكمال، وتَتَقَوَّى وتَتَرَقَّى وتُثمر وتَتَكَمَّلُ، وتؤدي وظائفها، أما الحياة الرتيبة على فراش الراحة فهي أقرب إلى العدم الذي هو الشر المحض منها إلى الوجود الذي هو الخير المحض، وتؤدي إليه.
الوجه الثالث: إن دار الدنيا هذه ميدان امتحان ودار خدمة، وليست محل لذة وأجرة ومكافأة، وبما أنها دار خدمة ومحل عبودية؛ فإن الأمراض والمصائب -بشرط ألا تكون دينيةً، وبشرط الصبر عليها- تنسجم مع تلك الخدمة والعبودية انسجامًا تامًّا، وتقويها، فينبغي الشكر عليها وليس الشكوى منها؛ لأنها تجعل كلَّ ساعة كعبادة يوم كامل.
أجل؛ إن العبادة قسمان، أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، فالإيجابي منهما معلوم، وأما السلبي منهما فهو أن المصابَ يُدرِكُ بالأمراض والمصائب ضعفَه، ويشعر به، فيلتجئ ويرجع إلى ربه الرحيم، ويراقبه، ويتضرع إليه، وبذلك يكون
8. صفحة
قد أدَّى عبادةً خالصةً، فهذه العبودية خالصة لا يتسرب إليها الرياء، فإنْ صَبَرَ المرء عليها واحتسب ثواب المصيبة، وشكر ربَّه عليها، فعندئذ تنقلب كل ساعة من ساعاتها إلى عبادة يوم كامل، ويتحول عمره القصير إلى عمر طويل، بل إن هناك قسمًا منها تتحول كل دقيقة منه إلى عبادة يوم كامل، حتى إنني كنت أقلق كثيرًا على المرض الشديد لأحد إخواني في الآخرة وهو الحافظ أحمد المهاجر، فأُلْهِم قلبي أن هَنِّئْه، إن كل دقيقة من دقائق مرضه تتحول إلى عبادة يوم كامل، والحقيقة أنه كان يشكر الله في صبر.
النكتة الثالثة: كما بيّنّا في بعض "الكلمات" أن كل إنسان إذا فكر في حياته الماضية، فقلبه ولسانه إما سيقولان: أوَّاه! أو الحمد لله، أي إما أن يتأسف ويتحسر، وإما أن يحمد ويشكر؛ فالذي يدفع إلى الأسف هو الآلام المعنوية الناشئة عن زوال لذائذ الزمان القديم وفراقها؛ لأن زوال اللذة ألم، وأحيانًا تورث لذةٌ مؤقتة آلامًا دائمة، فالتفكر فيها ينكأ جروح ذلك الألم ويجدده، ويقطر الأسف، أما اللذة والمتعة المعنوية الدائمة الناشئة عن زوال الآلام المؤقتة التي أصابت المرء في حياته القديمة فتجعله يقول: الحمد الله، وإذا ما فَكَّرَ -وهذه فطرته- في الثواب والمكافأة الأخروية التي هي نتيجة المصائب، وفي تحول عمره القصير إلى عمر طويل مديد بواسطة المصائب؛ فإنه سيكون شاكرًا أكثر منه صابرًا، ويقتضي ذلك أن يقول "الحمد لله على كل حال سوى الكفر والضلال"، وهناك قول مشهور يقول: "زمن المصائب طويل".
أجل؛ إن زمن المصيبة طويل، ولكنه ليس بطويل كما يُظَنّ في عُرْف الناس بما فيه من ضِيقٍ وشدة وألم، بل طويل لأنه يثمر نتائج حياتية كعمر طويل.
النكتة الرابعة: كما بُيِّنَ في "المقام الأول" من "الكلمة الحادية والعشرين"، من أن الإنسان إن لم يُشتِّت قوةَ الصبر التي وهبها الله له في طريق الأوهام؛ فإن هذه القوة يمكن أن تكفي لمواجهة كل المصائب، ولكن الإنسان إذا شتَّتَ قوة الصبر وفرّقها للماضي والمستقبل بسبب تحكم الوهم، وبسبب الغفلة، وبتوهمه الحياة الفانية باقيةً؛ فلا يكفي الصبر عندئذ لمواجهة المصيبة
9. صفحة
الحاضرة الراهنة، فيبدأ الإنسان بالتَّشَكِّي والتأوه والاستياء، وكأنه يشكو الله للناس حاشاه تعالى! فيشكو جائرًا وبلا حقّ وبجنون، ويجزع؛ لأن كل يوم مضى إن كان قد انقضى في المصيبة فقد ذهبت مشقته وبقيت راحته، وزال ألمه وبقيت لذته الناشئة عن زواله، وانقضى ضيقه وعسره وبقي ثوابه، إذن فينبغي عدم الشكوى من ذلك، بل ينبغي الشكر عليه في لذة ومتعة، وينبغي عدم السخط عليه، بل ينبغي أن نحبَّ تلك الأيام؛ لأن عمره الفاني الذي قد مضى ينقلب إلى نوع من عمر باقٍ وسعيد بواسطة المصيبة؛ لذا فمن البلاهة والجنون التفكيرُ في آلامها بالوهم، وتشتيت بعض من الصبر تجاهها، أما الأيام الآتية فبما أنها لم تَأْتِ بعدُ؛ فالتفكير من الآن فيما سيُعَانَى منه في تلك الأيام من الأمراض أو المصائب، والجزع عليها والشكوى منها حماقةٌ، وكما أنه من الحماقة أن يشرب الإنسان طول اليوم ويأكل باستمرار خشية أن يصبح جائعًا وعطشان غدًا أو بعد غدٍ؛ كذلك فالتفكر فيما سيأتي في الأيام المقبلة من المصائب والأمراض التي هي معدومة الآن، والتألم منها من الآن، والجزع عليها، وأن يظلم الإنسان بذلك نفسه بنفسه دون أن يكون هناك أي اضطرار؛ بلاهةٌ تسلب عنه استحقاقه للشفقة والرحمة.
الحاصل: فكما أن الشكر يزيد النعمة؛ فكذلك الشكوى تزيد المصيبة، وتسلب عن صاحبها استحقاقه للرحمة.
كان قد ابتُلِي رجل مبارك في "أرضروم" بمرض شديد في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى، فَعُدْتُه؛ فاشتكى إليّ شكوى أليمة، فقال: لم أستطع النوم منذ مائة ليلة، فأشفقت عليه كثيرًا، وإذا بخاطر خطر على بالي فقلت: يا أخي، إن الأيام المائة الماضية التي قضيتها في المرض والضيق هي الآن بمنزلة مائة يوم من الفرح والسرور لك، فلا تَشْكُ متفكرًا فيها، بل اشكر عليها كلما نظرت إليها، أما الأيام المقبلة وبما أنها لم تأت بعدُ، فاعتمد فيها على رحمة ربك الرحمن الرحيم، فلا تبك قبل أن تُضرَب، ولا تخف من شيء غير موجود أصلا،
10. صفحة
ولا تصبغ العدمَ بصِبغةِ الوجود، وتفكَّر في هذه الساعة فحسب، فقوة صبرك تكفي لهذه الساعة، ولا تتصرفْ تصرفَ قائدٍ أحمق التحقت ميمنة العدو بميمنة جيشه، فصارت له قوةً جديدةً، ولكنه أرسل قوة عظيمة إلى الميمنة، وأرسل قوة أخرى عظيمة إلى الميسرة، مع أنه لم يكن هناك جنود للعدو ولم يأتوا بعد، فأضعف بذلك المركزَ كليًّا، فأدرك العدو الأمر فهاجم المركزَ، فهزمه هزيمة نكراء.
قلت له: يا أخي لا تتصرفْ مثله، بل اجمع واحشد كل قوتك لهذه الساعة فحسب، وفكِّر في الرحمة الإلهية والمكافأة الأخروية، وفي تحويلك عمرَك الفاني إلى عمر باقٍ خالد، واشكر في سرور وفرح بدل هذه الشكوى المريرة؛ فانْشَرَحَ انشراحًا تامًّا، وقال: الحمد لله لقد شُفيت بنسبة تسعين بالمائة.
النكتة الخامسة: وهي "ثلاث مسائل":
المسألة الأولى: المصيبة الحقيقية والْمُضرة هي المصيبة التي تصيب الدين، فلابد من الاستعاذة بالله دومًا من المصيبة الدينية، والالتجاء والفزع إليه؛ فالمصائب غير الدينية لا تعد مصيبةً من زاوية الحقيقة، فبعضها تنبيه وإيقاظ رحماني، فكما أن الراعي يقذف حجارة على غنمه التي دخلت في مزرعة شخص آخر، فتشعر الأغنام منها أنها إيقاظ وتنبيه لإنقاذها من الخطر، فترجع بكل سرور ورضا؛ فكذلك ثمة مصائب ظاهرية كثيرة هي إيقاظ وتنبيه إلهي لنا، وبعضها كفارة للذنوب، وبعضها يُبدِّدُ الغفلةَ ويُشعِر الإنسانَ بضعفه وعجزه البشري، ويمنحه استشعار رقابة الله نوعا ما، فالأمراض التي هي نوع من المصيبة ليست مصيبة، بل هي إكرام إلهي، وتطهير كما ذُكر سابقًا، وقد ورد في الحديث ما معناه: أنه تتساقط خطايا المريض الذي أصيب بالحمّى كلما ارتجف([1]) كما تتساقط الثمار اليانعة من الشجرة بهزها.
11. صفحة
فسيدنا أيوب عليه السلام لم يَدْعُ الله في مناجاته لراحة نفسه، بل سأله الشفاء من أجل العبادة عندما حالت المصيبة بينه وبين الذكر اللساني والتفكر القلبي.
فيجب علينا أن ننوي -أولا وقبل كل شيء- بتلك المناجاة شفاءَ جروحنا المعنوية والروحية الناشئة عن الذنوب والآثام، وأما الأمراض المادية فيمكننا أن نلتجئ إلى الله تعالى عندما تمنعنا من القيام بعبادتنا، ولكن ليس بشكل الاعتراض عليها ولا بالشكاوى منها، بل متذللين ومستغيثين بالله تعالى، وبما أننا راضون بربوبيته تعالى؛ فلابد أن نرضى إذن بكل ما يقدره لنا بتلك الربوبية.
ولكن الشكوى بتأفف وتضجر التي يُشمُّ منها رائحة الاعتراض على القضاء والقدر، هي انتقاد للقدر واتهام للرحمة نوعًا ما، فمن ينتقد القدر يضرب رأسه بالسندان ويكسره، ومن يتهم الرحمة يُحرَم من الرحمة، فكما أن استخدام اليد المكسورة للانتقام والثأر يزيد من كسرها؛ فكذلك المبتلى بالمصيبة إذا قابلها بالتضجر والتشكي المومئ بالاعتراض يجعل المصيبة مصيبتين.
المسألة الثانية: كلما استُعظِمت المصائبُ المادية عَظُمت، وكلما استُصغِرت صَغُرت، فمثلا: يتراءى شبح للإنسان في الليالي، فكلما اهتم به انتفخ وكبر، وإن أهمله ولم يهتم به زال واختفى، وكما أن التعرض للزنابير المهاجِمةِ يزيد من هجومها، وعدم المبالاة بها يفرقها؛ فكذلك المصائب المادية كلَّما استعظمها الإنسان واهتم بها عظمت، وبسبب القلق منها تنفذ تلك المصائب في الجسد، وتستقر في القلب وتتأَصَّلُ، وتُولِّد مصيبة معنوية، فتستند إليها وتستمر، ومتى ما أزال الإنسان ذلك القلق بالرضا بالقضاء، وبالتوكل عليه تعالى؛ فإن المصيبة المادية تتلاشى وتجف بالتدريج كما تجف وتيبس الشجرة إذا ما قُطعت جذورُها، ولقد قلت ذات مرة لبيان هذه الحقيقة:
دع الصراخ والعويل من البلية أيها المسكين، تعال وتوكل.
إذ الصراخ والعويل خطأ وهو بلاء في بلاء، فاعلم.
إن وجدت من ابتلاك لمست عطاء في الصفاء والهناء الكامنين في البلاء، فاعلم.
12. صفحة
وإن لم تجده فالدنيا كلها جفاء في فناء، فاعلم.
ولِمَ تصرخ من بلاء صغير وأنت مصاب ببلاء ملء الدنيا؟! فتعال وتوكل.
فابتسم في وجه البلاء بالتوكل حتى يبتسم هو أيضًا.
فكلما ابتسم تصاغر وتبدل.
فكما أن العداء ينقلب إلى الصلح، وتتحول الخصومة إلى المزاح بالابتسام في وجه عدو لدود في أثناء الشجار أو النزال، ويتضاءل العداء ويزول؛ فكذلك الأمر في مواجهة المصيبة بالتوكل.
المسألة الثالثة: لكل زمان حكمه، وقد غيرت المصيبة شكلها في زمن الغفلة هذا، فليست المصيبة مصيبةً عند البعض في بعض الأوقات، بل هي لطفٌ إلهيٌّ، وأنا أرى أن المبتَلَيْنَ بالأمراض في هذا الزمان -على ألا تَمَسّ الدين- محظوظون وسعداء، فلا يجعلني هذا ضد الأمراض والمصائب، ولا يورث لديَّ شعورًا بالرقة لهم؛ ذلك لأني لم يأتني شابٌّ مريض إلا وكنت أراه أكثر صلة بالوظيفة الدينية والآخرة مقارنة بأمثاله، وأُدرِكُ من هذا أن تلك الأمراض التي تصيبهم ليست مصيبة في حقّ مثل هؤلاء، بل هي نوع من نعمة إلهية؛ لأن هذا المرض على الرغم مما يورثه من مشقة لحياته الدنيوية الفانية القصيرة؛ فإنه ينفع حياته الأبدية، ويتحول إلى نوع من العبادة، فإن صحَّ وعوفي فلربما أنه لن يستطيع الحفاظ على حالته التي كان عليها في المرض بسبب سكر الشبيبة، وبالسفاهة المنتشرة في هذا الزمان، بل ربما يقتحم السفاهة والطيش.
الخاتمة: إن الله سبحانه وتعالى قد أدرج في الإنسان عجزًا لا حدَّ له، وفقرًا لا نهاية له، حتى يُظهرَ قدرته التي لا حدَّ لها، ورحمته التي لا نهاية لها، وخلقه كماكينة حتى يريه نقوش أسمائه التي لا حد لها؛ إذ يمكن أن يتألم الإنسان من وجوه غير محدودة، كما يمكنه أن يَتَمَتَّعَ ويتلذذ من وجوه غير محدودة، ففي هذه الماكينة البشرية مئات من الآلات، فلكل واحد منها ألم خاص، ولذة مستقلة، ووظيفة مختلفة، ومكافأة خاصة، وكأن جميع الأسماء الإلهية التي تتجلى على
13. صفحة
العالم -الذي هو الإنسان الأكبر- تَتَجَلَّى كذلك على الإنسان -الذي هو العالم الأصغر- وتظهر تجليات جميع هذه الأسماء على الإنسان، فكما أن الأمور النافعة كالصحة والعافية واللذائذ والتمتع؛ تسوق الإنسان إلى الشكر، وتدفع تلك الماكينةَ، بوجوه كثيرة إلى القيام بوظائفها، ويصير الإنسان كمصنع الشُّكر؛ فكذلك تُحرّك تلك الأسماء الإلهية التروسَ الأخرى في تلك الماكينة وتستخرج بالمصائب والأمراض والآلام وبسائر العوارض المهيِّجة والمحركة ما هو مندرج في الماهية الإنسانية من معدن العجز والفقر والضعف، وتسوق الإنسان إلى الالتجاء إلى الله تعالى، والاستغاثة به ليس بلسان واحد فحسب بل بلسان كل عضو، وكأن الإنسان يصبح بتلك العوارض قلمًا متحركًا يتضمن آلاف الأقلام المختلفة، فيَكتُبُ في صحيفة حياته أو في اللوح المثالي مُقدَّرات حياته، ويجعل صحيفة حياته لوحة إعلان تعلن وتعرض الأسماء الإلهية، ويصبح قصيدة سبحانية منظومة؛ فيؤدي وظيفتَه الفطرية.