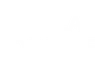المكتوب الثاني والعشرون:
التنقل
132. صفحة
المكتوب الثاني والعشرون
باسمه وإن من شيء إلا يسبح بحمده
هذا المكتوب عبارة عن مبحثين:
المبحث الأول يدعو أهل الإيمان إلى الأخوة والمحبة
المبحث الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (الحجرات:10)
﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت:٣٤)
﴿وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ (سورة آل عمرن:1٣٤)
إن التحايز والعنادَ والحسدَ المسبِّب للنفاق والشقاق والحقد والعداوةِ بين المؤمنين مَشين ومردود من حيث الحقيقة، ومن حيث الحكمة، ومن حيث الإسلامية التي هي الإنسانية الكبرى، ومن حيث الحياة الشخصية، ومن حيث الحياة الاجتماعية، ومن حيث الحياة المعنوية، فهو مضر وظلم، بل سُمٌّ للحياة البشرية.
وسنبين ستة أوجه من الوجوه الكثيرة جدًّا لهذه الحقيقة:
الوجه الأول:
إنه ظلم من حيث الحقيقة، فيا من امتلأ قلبه حقدًا وعداء لأخيه المؤمن، ويا من لا إنصاف له: كما أنك لو كنت في سفينة أو في دار ومعك تسعة أبرياء ومجرم واحد،
133. صفحة
فإنك تعلم مدى ظلم من يحاول إغراق هذه السفينة أو إحراق تلك الدار، وستصرخ بأعلى صوت حتى توصل ظلمه إلى السماوات؛ إذ ليس هناك أي قانون عادل يسوغ إغراق هذه السفينة حتى لو كان فيها تسعة جناة ما دام بها بريء واحد.
فكما في هذا المثال، فإنك بعداوتك للمؤمن الذي هو بناء رباني وسفينة إلهية من أجل صفة مجرمة واحدة في كيانه تضرك ولا تعجبك - مع أن له تسع صفات بريئة بل عشرين صفة كالإيمان والإسلام والجوار - ترتكب ظلما شنيعًا، وذلك بالمحاولة والرغبة - معنىً - في إحراق ذلك البناء المعنوي وتخريبه وإغراقه.
الوجه الثاني:
إنه ظلم من حيث الحكمة أيضا؛ إذ من المعلوم أن العداء والمحبة ضدان مثل النور والظُّلمة، فلا يمكن الجمع بينهما بمعناهما الحقيقي، فإذا كانت المحبة موجودة وجودا حقيقيا في قلبٍ ما حسب رجحانية أسبابها؛ فعندئذ تكون العداوة مجازيةً، وتنقلب إلى صورة الإشفاق.
نعم؛ فالمؤمن يحب أخاه وعليه أن يحبه، ولكنه إذا رأى منه عملا سيئا فلا يكتفي بأن يشفق عليه وحسب، بل يحاول إصلاحه باللطف وليس بالتحكم، لذا "لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ([1])" كما في نصِّ الحديث الشريف.
وأما إذا ما تغلبت أسباب العداوة وتمكنت من قلبٍ ما حقيقةً، فعندها تكون المحبةُ مجازيةً، وتلبس لباس التصنع والتملق.
فيا أيها الرجل غير المنصف، انظر:
ما أشنع أن تحمل حقداً وعداوةً لأخيك المؤمن؛ لأنه كما أنك إذا ما استعظمت حصيات صغيرات تافهة، واعتبرتها أهم من الكعبة وأعظم من جبل أحد فإنك بذلك ترتكب حماقة حمقاء؛ فكذلك مع أن صفات مسلمة كثيرة كالإيمان الذي له حرمة كحرمة الكعبة والإسلام الذي هو عظيم كعظمة جبل أحد تقتضي المحبةَ والاتفاقَ، فإن تفضيل بعض التقصيرات - التي تتسبب في العداوة تجاه المؤمن والتي هي بمنزلة
[1] هو جزء من الحديث رقم ٥٧٢٧ في صحيح البخاري: ك الأدب، بَاب الْهِجْرَةِ وَقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث.
134. صفحة
حصيات تافهة - على الإيمان والإسلام؛ هو جور وتعسف وحمق وظلم عظيم، إن كنتَ عاقلا فستفهم ذلك.
نعم؛ وحدة الإيمان تستدعي توحيد القلوب حتما، ووحدة الاعتقاد أيضا تقتضي وحدة المجتمع، فأنت لا تستطيع أن تنكر أنك تشعر بعلاقة الخلَّة تجاه شخص كان معك في طابور واحد، وتشعر تجاهه بعلاقة الصداقة لوجودكما معا تحت قيادة قائد واحد، وتشعر بعلاقة الأخوة لوجودكما معا في بلدة واحدة، والحال أنه توجد كثير من علاقات الوحدة وروابط الاتفاق ووشائج الأخوة بعدد أسماء الله الحسنى التي أوضحها وجلاَّها لك الإيمان من خلال النور والشعور اللذين منحك إياهما.
فمثلا: إن خالقكما واحد، ومالككما واحد، ومعبودكما واحد، ورازقكما واحد، وهكذا الوحدة إلى أن تبلغ الألف، ثم إن نبيكما واحد، ودينكما واحد، وقبلتكما واحدة، وهكذا الوحدة إلى أن تبلغ المائة، ثم إن قريتكما واحدة، ودولتكما واحدة، وبلدتكما واحدة، وهكذا الوحدة إلى أن تبلغ العشرة.
فإن كان هناك هذا القدر من الروابط التي تقتضي الوحدة والتوحيد والوفاق والاتفاق والمحبة والأخوة، ولها من القوة المعنوية العظيمة ما يربط أجزاء الكون والأجرام السماوية، فما أظلم من يتركها ويرجِّح عليها أمورا واهية كبيت العنكبوت لا ثبات لها، تلك التي تولد الشقاق والنفاق والحقد والعداء، فيوغر صدره بعداء حقيقي وحقد تجاه أخيه المؤمن، فما أظلم ذلك وما أكثره من إهانة لتلك الروابط التي توحد، وما أكثره من استخفاف بتلك الأسباب التي توجب المحبة، وما أكثره من ظلم وتعسف لتلك العلاقات التي تفرض الأخوة، فإن لم يكن قلبك ميتا، ولم تنطفئ بعد جذوة عقلك، فستدرك هذا.
الوجه الثالث:
مع أن الحقيقة والشريعة والحكمة الإسلامية تذكرك - بسر ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام:1٦٤) التي تفيد العدالة المحضة - بأن الحقد والعداوة تجاه مؤمن - وكأنك تحكم على صفاته الأخرى لسبب صفة مجرمة فيه - ظلم ما بعده ظلم، ولا سيما توسيعك دائرة العداء لتشمل أقاربه وذويه بسبب صفة تمتعض
135. صفحة
منها، وتذكرك بأنك ترتكب بذلك ظلما عظيما كما وصفته الآية الكريمة بصيغة المبالغة ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾(إبراهيم:34)، فكيف تدعي أنك مُحِقٌّ وتقول: "إن الحق معي"؟
إن المفاسد التي هي سبب العداوة والشر كثيفة في نظر الحقيقة كالشر والتراب، فينبغي ألا تسري إلى الغير وألا تنعكس عليه، إلا أنه إذا كان أحدهم يمتثلها ويأتي بشر فهذه قضية أخرى، وأما صنائع المعروف التي هي أسباب المحبة فهي نور مثل المحبة، وشأنها السريان والانعكاس؛ لذا صار قول: "صديق الصديق صديق" من ضروب الأمثال، ولذا صار يتردد في ألسنة العوام قول "مِن أجل عين واحدة تُحَبُّ ألفُ عين".
فيا أيها الرجل عديم الإنصاف!
ما دامت الحقيقة تَرَى هكذا؛ فإنك إن كنت عارفا بالحقيقة فإنك تفهم كيف أن عداوتك لأخٍ بريء ومحبوب لدى رجل تكرهه ولدى ذويه خلاف للحقيقة.
الوجه الرابع: إنه ظلم من حيث الحياة الشخصية.
فاستمع إلى بضعة دساتير هي أساس هذا الوجه الرابع:
الدستور الأول:
عندما تعتقد أنك على حق في مسلكك وفي أفكارك يحق لك أن تقول: "إن مسلكي حق" أو "هو أفضل"، ولكن لا يحق لك أن تقول "إن الحق هو مسلكي أنا فحسب"؛ لأنه لا يمكن أن يكون نظرك غير المنصف وفكرك القاصر حكما، ولا يستطيع أن يقضي على بطلان مسالك الآخرين بسر:
وعينُ الرضا عن كلِّ عيبٍ كليلةٌ ولكن عينَ السُّخطِ تُبدي المُسَاويا
الدستور الثاني:
ينبغي عليك أن تقول الحق في كل ما تقول، إلا أنه ليس لك حق أن تقول كل الحقائق، وينبغي أن يكون كل ما تقوله صدقا، ولكنه ليس من الصواب أن تقول كل صدق؛ لأن من كان على نية غير خالصة
– مثلك - يمكنه أن يثير العروق النفسانية عند من ينصحه، فتأتي نصيحته بتأثير سلبي، ويحدث عكس المراد منها.
136. صفحة
الدستور الثالث:
إن كنت تريد أن تعادي فعاد ما في قلبك من عداوة، واجتهد في استئصالها، وعاد نفسَك الأمارة، وهوى نفسك التي هي أشد ضررا عليك من غيرها، واسع إلى إصلاحها، ولا تعاد المؤمنين من أجل تلك النفس المضِرَّة.
وإن كنت تريد العداء؛ فالكفار والزنادقة كُثر، فعادِهم.
أجل؛ فكما أن صفة المحبة جديرة بالمحبة؛ كذلك فإن خصلة العدواة تستحق العداء قبل أي شيء آخر.
وإن كنت تريد أن تتغلب على خصمك فادفع سيئته بالحسنة؛ لأنك إن قابلت إساءته بإساءة فستزداد الخصومة، حتى إن كان مغلوبا في الظاهر؛ فإنه سيحمل في قلبه حقدا ويستمر في العداء، ولكنك إن قابلت إساءته بالإحسان فسيندم، ويكون صديقا لك؛ لأنَّ شأنَ المؤمن أن يكون كريما بحسب:
إِنْ أنت أَكرَمتَ الكريمَ مَلكتَه وإن أنت أَكرَمتَ اللَّئِيمَ تَمَرّدَا
فبإكرامك إياه يكون مسخّرا لك، حتى ولو كان لئيما في الظاهر فهو كريم من حيث الإيمان.
نعم؛ إنه يحصل كثيرا أن تتحسن أخلاق رجل فاسد بقولك له باستمرار: "إنك صالح، إنك صالح"، وأن يفسد رجل صالح إن قلت له باستمرار: "إنك طالح، وإنك فاسد"؛ لذا ألقِ السمعَ إلى الدساتير القرآنية المقدسة مثل: ﴿َإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقان:72) و﴿وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتغْفِروُا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ﴾(التغابن:١٤) حيث إن السعادة والسلامة فيها.
الدستور الرابع:
إن أهل الحقد والعداوة يظلمون أنفسهم وإخوانهم المؤمنين والرحمة الإلهية، ويتجاوزون حدودها؛ حيث إنه بالحقد والعداء يوقع نفسه في عذاب أليم؛ إذ يُجرِّع نفسَه عذابا مما يحل بخصمه من نِعَم، وآلاما ناشئة عن خوفه، فيظلم بذلك نفسه.
فإن كانت العداوة تنشأ عن الحسد فهو عذاب في عذاب؛ لأن الحسد يسحق ويوجع ويحرق الحاسد أولا، أما المحسود فلا يورثه الحسد ضررا، وإن تضرر منه فسيتضرر قليلاً.
137. صفحة
وعلاج الحسد هو:
أن يفكر الحاسد في عاقبة حسده، حتى يدرك أن ما لدى منافسه من أعراض دنيوية من حسن وقوة ومنصب وثروة فانية مؤقتة فوائدها قليلة ومشقاتها كثيرة، أما المزايا الأخروية فلا حسد فيها أصلا، فإذا كان يحسد حتى في تلك المزايا الأخروية فإما أنه مراءٍ يريد أن يمحو بضاعة الآخرة في الدنيا، وإما أنه يظن أن محسوده مراء فيظلمه.
ثم إن الحاسد بسروره بالمصائب النازلة على محسوده، وبحزنه على مجيء النعم إليه يكون ساخطا على القدر والرحمة الإلهية لما تُقدِّم للمحسود من خيرات، فكأنه ينتقد القَدَر ويعترض على الرحمة الإلهية، ومن ينتقد القَدَر فإنه يضرب رأسه على سندان([1]) فيكسره، ومن يعترض على الرحمة يُحرَم منها.
فيا ترى أي إنصاف يقبل أن يمتلئ الصدر لسنة كاملة حقدا وعداء لشيء لا يستحق العداء ليوم واحد؟ وأي ضمير لم يفسد يرضى بذلك؟
والحال أنك لا تستطيع أن تنسب سيئةً أتتك من أخيك المؤمن إليه كليًّا وتدينه بها؛ لما يلي:
أولا: للقدر الإلهي سهم في ذلك الأمر، فينبغي تصفيته ومقابلة تلك الحصة بالرضا.
ثانيا: تصفية سهم النفس والشيطان، والإشفاق عليه بدل العداء، ملاحظًا أنه غُلِب أمام نفسه، متوقعا ندامته.
ثالثا: انظر إلى قصورك الذي لم تره، أو الذي لا تريد أن تراه، وأعطه كذلك قسطا.
ثم إذا ما قابلت ما تبقى من قسط ضئيل بعفو وصفح وشهامة عالية مما يغلب خصمك بصورة أسلم وأسرع، فستنجو من الظلم والضرر؛ ولكن المقابلة بحرص شديد على أمور دنيوية فانية زائلة مؤقتة تافهة لا تساوي فلسا، وكأنك خالد في الدنيا، وتعيش دائما فيها؛ مثل يهودي تاجر ألماس أحمق عربيد، يشتري قطعا زجاجية وبلورات ثلجية بثمن الألماس، والمقابلة بحقد مستديم وعداء لا يفتر هو ظلم بصيغة المبالغة، أو سُكرٌ، أو جنون نوعا ما.
[1] السندان: ما يطرق الحداد عليه الحديد.
138. صفحة
فإن كنت تحب ذاتك فلا تفسح مجالا للعداء وفِكْرِ الانتقام المفسدين للحياة الشخصية إلى هذا الحد ليَدخلا قلبك، وإن كانا قد دخلا في قلبك فعلا فلا تصغ إليهما، وانظر ماذا يقول حافظ الشيرازي العارف بالحقيقة واستمع إليه:
دنيا نه متاعست كه ارزد بنزاعي
أي: إن الدنيا ليست متاعا يستحق النـزاع عليه، فهي تافهة لأنها فانية ومؤقتة، فلئن كانت الدنيا كلها هكذا فإنك تفهم مدى تفاهة الأمور الجزئية المتعلقة بها، وقد قال أيضا:
آسايش دوكيتي تفسير اين دو حرفست بادوستان مروَّت با دشمنان مدارا
أي: إن الراحة والسلامة في كلا العالمين توضحهما وتكسبهما كلمتان:
معاشرة الأصدقاء بالمروءة، ومعاملة الأعداء بالمصالحة.
فإن قلت: لا أستطيع التحكم في إرادتي، فالعداء مغروز في فطرتي، ثم إنه قد جُرِحت مشاعري، فلا أستطيع أن أتخلى عن العداء.
فالجواب: إن لم يكن لسوء الخُلق والخصال الذميمة أثر ظاهر، وإن لم تلجأ إلى أمور كالغيبة وتوابعها، وعَرف صاحبُ العداوة تقصيرَه؛ فلا ضرر من ذلك، فما دام الأمر ليس بيدك، ولا تستطيع التخلي عن العداء؛ فإن شعورك بتقصيرك الذي هو في حكم ندم معنوي وتوبة خفية واستغفار ضمني، وإدراكَك بأنك غير محق في هذه الخصلة؛ ينجيانك من شر العداء، ونحن ما كتبنا هذا المبحث من هذا المكتوب إلا ليضمن هذا الاستغفار المعنوي، ولئلا يفهم المرءُ الباطلَ حقّا ولئلا يُشهِّر بخصمه المحق بأنه ظالم غير محق.
حادثة جديرة بالملاحظة:
رأيت ذات يوم - وكنتيجة لهذا التحيّز المغرِض - رجلا ديِّنا من أهل العلم يقدح في عالم فاضل يخالفه في فكره السياسي قدحا وصل إلى حد التكفير، ويثني على منافق يوافقه الرأي السياسي باحترام، فارتعدتُ من هذه النتائج الفاسدة للسياسة، وقلت: "أعوذ بالله من الشيطان والسياسة"، ومنذ ذلك الوقت انسحبت من ميدان الحياة السياسية.
139. صفحة
الوجه الخامس:
يبين أن العناد والتحيز مفسد جدًّا للحياة الاجتماعية.
فإن قيل: لقد ورد في الحديث الشريف "اختلاف أمتي رحمة"([1]) فالاختلاف يقتضي التحيّز، وداء التحيز ينقذ العوام المظلومين من شر الخواص الظالمين؛ لأنه إذا اتفق خواصُّ قرية أو بلدة فيما بينهم اضطهدوا العوام المظلومين، ولكن إن كان ثمة تحيز فإن المظلوم يلجأ إلى طرف ما، فينقذ نفسه؟ ثم إن الحقيقة تظهر جلية من تصادم الأفكار وتخالف العقول؟
فالجواب ما يلي:
نقول إجابة عن السؤال الأول:
إن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف المثبت الإيجابي، أي: يسعى كل واحد لإصلاح وترويج مسلكه، لا لهدم وتخريب مسالك الآخرين، بل يسعى لإكمالها وإصلاحها.
أما الاختلاف السلبي فهو سعي كل واحد لهدم مسالك وأفكار الآخرين بحقد وعداوة، وهو مردود في نظر الحديث؛ لأن الذين يتنازعون ويتشاحنون فيما بينهم لا يستطيعون أن يقوموا بعمل إيجابي.
ونقول إجابة عن السؤال الثاني:
إن التحيز إذا كان من أجل الحق فقد يكون ملاذا للمحقين، ولكن التحيز المغرض المعاند الذي يكون لحساب النفس والذي نراه في الوقت الراهن هو ملاذ للجائرين، حيث يصبح نقطة استناد لهم؛ لأنه إذا أتى شيطان وساعد من يتحيز تحيزا مغرضا وانحاز لفكره فهذا الرجل سيترحم على الشيطان، بينما إذا كان في الطرف المقابل له إنسان كالملك؛ فسيُبدِي جورا وظلما له لدرجة أن يلعنه.
ونقول إجابة عن السؤال الثالث:
إن تصادم الأفكار الحاصل باسم الحق وفي سبيل الحقيقة يختلف في الوسائل فقط مع الاتفاق في المقاصد والأساسات، ويُظهِر كلَّ زاوية من زوايا الحقيقة، فيَخدم الحق والحقيقة.
[1] الحديث في كنز العمال برقم ٢٨٦٨٦.
140. صفحة
ولكن تصادم الأفكار الناتج من انحياز وغرض بتكبر وأنانية، ومن أجل النفس الأمارة المتفرعنة ونيل الشهرة، لا تلمع منه بارقة الحقيقة، بل تُرمى منه شرارت الفتن؛ لأنه ينبغي الاتفاق في المقصد؛ إذ لا توجد نقطة تلاق لأفكار هؤلاء على الكرة الأرضية، ولأنه ليس من أجل الحق؛ تجد فيه إفراطا لا نهاية له، ويتسبب في انشقاقات غير قابلة للالتئام، وحاضر العالم شاهد على هذا.
الحاصل:
إن لم تكن الدساتير السامية "الحب في الله"، و"البغض في الله"، و"الحكم لله" دستورا للحركات؛ فالنفاق والشقاق يسودان.
نعم؛ إن لم يقل المرأ "البغض في الله"، و"الحكم لله"، ولم يضع تلك الدساتير نصب عينيه؛ يظلم في الوقت الذي ينشد فيه العدالة ويبغيها.
حادثة ذات عبرة:
وفي وقت ما تغلَّب الإمام علي رضي الله عنه على كافر وألقاه أرضا، ثم سلَّ سيفه ليقتله، فبصق الكافر في وجهه، فترك ذلك الكافرَ ولم يقتله، فقال له الكافر: لِمَ لم تقتلني؟ قال: كنت سأقتلك في سبيل الله، ولكنك بصقت في وجهي فثار غضبي، وتدخَّلت نفسي، فجُرِح إخلاصي؛ لذا لم أقتلك، فقال له الكافر: كان قصدي إثارة غضبك حتى تسرع في قتلي، وإذا كان دينكم صافيًا وخالصًا إلى هذا الحد؛ فهو دينٌ حقٌّ.
وحادثة أخرى لافتة للنظر: لما كان أحد القضاة يقطع - ذات مرة - يد سارق بدا منه أثر الحدة والغضب، فعزله واليه العادل الذي رأى منه تلك الحالة في تلك الوظيفة؛ لأنه لو كان يقطع باسم الشريعة والقانون الإلهي لأشفقت نفسه عليه، ولكان سيقطع في حالة لا يغضب فيها قلبه عليه ولا تأخذه به شفقة.
إذن فهو لم يستطع القيام بعمله بالعدل؛ لأنه قد أعطى لنفسه حظا من ذلك الحكم.
حالة اجتماعية مؤسفة ومرض اجتماعي خطير يدمي قلبَ المسلمين:
إنه الأقوام الضاربين في البداوة ينبذون العداوات الداخلية وينسونها عند ظهور وهجوم الأعداء الخارجيين، أي إنهم يدركون هذه المصلحة الاجتماعية، فما للذين
141. صفحة
يدَّعون أنهم يخدمون الإسلام لا ينسون عداواتهم الجزئية فيمهدون سبل إغارة الأعداء عليهم، مع أن هنالك أعداء لا حصر لهم يستعدون للهجوم عليهم!
إن هذه الحالة سقوط ووحشية وخيانة للحياة الاجتماعية الإسلامية.
حكاية ذات عبرة:
كان هناك عشيرتان من قبيلة "حسنان" بينهما عداء، فمع أن كل واحدة منهما قتلت أكثر من خمسين شخصا من الأخرى؛ فإنه إن هجمت عليهم قبيلة كقبيلة "سبكان" أو "حيدران" فإن هاتين العشيرتين المتعاديتين تنسيان عداوتهما القديمة وتقفان جنبا إلى جنب، ولا تفكران في عداوتهما الداخلية إلى أن تصدا ذلك العدو الخارجي.
فيا معشر المؤمنين!
أتدرون كم يبلغ عدد الأعداء - الذين هم بمنزلة العشائر - المتأهبين للإغارة على عشيرة أهل الإيمان؟ هم أكثر من مائة دائرة كالدوائر المتداخلة.
فهل يليق بأهل الإيمان - بأي وجه من الوجوه - الانحياز إلى غرضٍ، والعناد في عداء، اللذان هما بمنزلة تسهيل هجوم الأعداء عليهم وفتحِ الأبواب لدخولهم إلى حرم الإسلام، في حين أنهم مضطرّون لأن يتخذوا وضع الدفاع تجاههم متكاتفين متساندين!
وإن دوائر الأعداء ابتداء من أهل الضلالة والإلحاد وانتهاء إلى عالم الكفر وأهوال الدنيا ومصائبها، هي دوائر متداخلة اتخذت أوضاعا مضرة لكم، ودوائر بعضها خلف بعض تنظر إليكم بطمع وغضب، فلربما تبلغ سبعين نوعا من الأعداء، فسلاحك القوي وخندقك الأمين وقلعتك الحصينة تجاه كل أولئك الأعداء هو الأخوة الإسلامية.
فاعلم - أيها المسلم – كم أن زعزعة هذه القلعة الإسلامية بعداوات صغيرة، وحجج واهية منافٍ للضمير ومخالف للمصلحة الإسلامية، فأفق!
وقد ورد في الأحاديث الشريفة: أن الأشخاص الخطيرين والمضرين الذين سيظهرون في آخر الزمان، ويرأسون حركات النفاق والزندقة مثل السفياني والدجال وأمثالهما، سيستغلون حرص وشقاق البشر والمسلمين، وسينشرون الهرج والمرج بينهم، ويأسرون العالم الإسلامي الكبير بقوة ضئيلة.
142. صفحة
فيا أهل الإيمان!
إن كنتم تريدون ألا تدخلوا تحت الأسر في ذُلٍّ فثُوبوا إلى رشدكم، وادخلوا القلعة الحصينة المقدسة ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ تجاه الظالمين الذين يستغلون خلافاتكم وتحصنوا بها، وإلا فلن تستطيعوا أن تحافظوا على حياتكم، ولن تستطيعوا أن تدافعوا عن حقوقكم.
فمن المعلوم أنه إذا تناحر بطلان؛ فإن طفلا صغيرا يستطيع أن يضربهما، وإذا كان هنالك جبلان متوازنان على ميزان؛ فحصاة صغيرة تستطيع أن تخل بموازنتهما وتلعب بهما، أي ترفع أحدَهما إلى الأعلى، وتنزل بالآخر إلى الأسفل.
فيا أهل الإيمان!
إنه لتضمحل قوتكم من جراء حرصكم وطمعكم وانحيازكم في حقد وعداء، فتنسحقون بقوة قليلة.
فإن كانت لكم علاقة بحياتكم الاجتماعية فاتخذوا الدستور السامي: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُه بعضًا"([1]) دستورا لحياتكم، لتنجوا من التعاسة والضنك الدنيوي والشقاء الأخروي.
الوجه السادس:
إن الحياة المعنوية وصحة العبودية تتزعزعان بسبب العداء والعناد؛ إذ يضيع الإخلاص الذي هو واسطة الخلاص ووسيلة النجاة، وذلك لأن المعاند المنحاز يروم التفوق على خصمه في أعماله الخيرية، وكثيرا ما لا يستطيع أن يوفّق إلى أعمال خالصة لوجه الله، ثم إنه كذلك يُرجّح من ينحاز إليه في أحكامه ومعاملاته فلا يستطيع أن يحكم بالعدل، فهكذا يضيع بالخصومة والعداوة "الإخلاص" و"العدالة" اللذان هما أساسان مهمان للأفعال والأعمال الخيرية.
هذا الوجه السادس طويل جدًّا، إلا أننا نكتفي بهذا القدر لأن قابلية المقام قصيرة.
[1] الحديث في صحيح البخاري برقم ٤٦٧، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
143. صفحة
المبحث الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ﴾ (الذاريات:٥٨)
﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾ (العنكبوت:٢٩)
فيا أهل الإيمان! لقد أدركتم سابقًا مدى ضرر العداء، فاعلموا أن الحرص كذلك هو من أكثر الأمراض خطرا وضررا على الحياة الإسلامية، إن الحرص سبب الخيبة، وعِلَّةٌ وذلّة، ويجلب الحرمان والفقر والبؤس.
نعم؛ إن ذلة وبؤس اليهود الذين يتكالبون على الدنيا بحرص أكثر من أي قوم آخرين لهو شاهدٌ قاطعٌ على هذا الحكم.
أجل؛ إن الحرص يُظهر تأثيره السيء بدءًا من أوسع دائرة في عالم الأحياء، وانتهاء إلى أصغر فرد فيه، أما السعي وراء الرزق بتوكل فهو - بالعكس - مدار للراحة، ويظهر تأثيره الحسن في كل مكان.
فالأشجار والنباتات المثمرة المفتقرة إلى الرزق - التي هي ذات حياة نوعا ما - ولأنها تقف في مكانها كأنها تتوكل في قناعة دون أن تبدي حرصا؛ تهرع إليها أرزاقُها فتغذي أولادا أكثر بكثير من الحيوانات.
أما الحيوانات ولأنها تجري وراء رزقها بحرص؛ فهي تتحصل على أرزاقها بعد عناء ومشقة كثيرة وبكمية ناقصة.
ثم إن الرزق المشروع الكامل اللطيف الذي يُعطَى - في عالم الحيوانات - من خزائن الرحمة للصغار الذين يتوكلون بلسان العجز والضعف، وإن الأرزاق الكريهة غير المشروعة للحيوانات المفترسة التي تهجم على أرزاقها بحرص، وتتحصل عليها بعد عناء ومشقة كثيرة؛ لَتُبَيِّنُ أن الحرص هو سبب الحرمان، وأن التوكل والقناعة هما وسيلتا الرحمة.
144. صفحة
وما نشاهده في عالم البشر عند اليهود الذين يتمسكون بالدنيا بحرص والذين يتعلقون بالحياة الدنيوية بعشق أكثر من أي قوم آخرين، حيث تلحق بهم ضربات الذل والمسكنة والقتل والإهانة مقابل ما يحصلون عليه من ثروة رِبَوية غير مشروعة ذات فائدة قليلة والتي لا يقومون إلا بادخارها فحسب؛ يبين أن الحرص معدن الذلة والخسارة.
وهنالك وقائع كثيرة تفيد أن الإنسان الحريص يقع دوما في الخسارة، حتى جرى "الحريص خائب خاسر" مجرى الأمثال واتخذه الجميع حقيقة عامة بعين الاعتبار.
فما دام الأمر هكذا، فإن كنت تحب المال حبًّا جمًّا، فلا تطلبه بالحرص، بل اطلبه بالقناعة؛ حتى يأتيك وفيرًا.
إن أهل القناعة وأهل الحرص يشبهان شخصين يدخلان إلى مجلس شخص عظيم، يتمنى أحدهما من قلبه قائلا: لو سمح لي بالدخول فقط في حضرته بحيث أنجو من البرد الذي في الخارج لكفاني، وإن سمح لي بالجلوس ولو في أقصى المجلس فسيكون لطفا منه.
أما الرجل الثاني فكأن له حقا على الآخرين، وكأنهم مضطرون إلى احترامه، فيقول بكل غرور: يجب أن يعطيني أعلى مقعد، ويدخل المجلس بذلك الحرص، ويتطلع إلى المواقع الرفيعة العالية، ويريد أن يصعد إليها، إلا أن صاحب المجلس يردّه ويُجلِسه في أقصى المجلس، فبدلا من أن يقدم الشكر الذي هو واجب عليه يغضب ويسخط من قلبه على صاحب المجلس، ولا يشكره، بل ينتقده، فيستثقله صاحب المجلس.
أما الرجل الأول فيدخل بكل تواضع، ويريد أن يجلس ولو على أقصى مقعد، فتسر هذه القناعة صاحب المجلس، فيقول له: تفضلوا إلى مقعد أعلى، والرجل بدوره كلما ارتقى يزداد شكره، ويزيد امتنانه.
وهكذا فالدنيا مضيف الرحمن، ووجه الأرض مائدة الرحمة، ودرجات الرزق ومراتب النعم بمنزلة المقاعد، وإن سوء تأثير الحرص يمكن أن يشعر به كل واحد حتى في أبسط الأمور، فمثلا عندما يسأل متسولان اثنان حاجة ما، يشعر كل شخص استثقالا
145. صفحة
في قلبه تجاه المتسول الحريص الذي يسأل بإلحاح ولا يعطيه شيئا، بينما يشعر بالشفقة تجاه المتسول الآخر الهادئ ويعطيه حاجته.
ومثلا: إذا أصبت بالأرق في الليل، وأردت أن تنام فيمكنك أن تنام إن لم تشغل بالك بالأرق، ولكن إن طلبت النوم بحرص وقلت: ترى متى يأتيني النوم؟ ومتى سأنام؟ فستفقد النوم كليا.
ومثلا: إنك تنتظر أحدَهم من أجل أمر مهمٍّ بحرص قائلا: لِمَ لَم يأت؟ ولِمَ تأخر؟ وفي النهاية يستنفد الحرصُ صبرَك، فتقوم وتغادر مكان انتظارك، وبعد دقيقة يأتي الرجل، ولكن النتيجة المهمة المرجوة قد ضاعت.
إن سر هذه الحادثات وحكمتها: مثلما يترتب وجود قطعة خبز على وجود المزرعة والبيدر والطاحونة والمخبز، فكذلك في ترتب الأشياء حكمة التأني، فالحريص لسبب عدم تأنِّيه بدافع الحرص لا يراعي الدرجاتِ المعنويةَ في الأشياء المرتَّبةِ، فإما أن يقفز فيسقط، وإما أن يدع إحدى تلك الدرجات ناقصة فلا يستطيع أن يرتقي إلى مقصده.
فيا أيها الإخوة المتحيرون الذاهلون بسبب هموم العيش، والسكارى بالحرص على الدنيا! كيف ترتكبون كلَّ أنواع الذل - مع أنه مضر وذو بلايا إلى هذا الحد - وتقبلون كل الأموال دون أن تبالوا أهي حلال أم حرام، وتضحون بأشياء كثيرة تستلزمها الحياة الأخروية، حتى إنكم تتركون في سبيل الحرص الزكاة التي هي ركن مهم من أركان الإسلام، علما بأن الزكاة وسيلة للبركة، ودافع للبلايا عن كل فرد، فالذي لا يؤتي الزكاة؛ لا محالة يخرج من يده مال بقدر الزكاة، فإما بالتبديد في أمور تافهة، وإما بمصيبة تصيبه فتنتزعه منه.
لقد سُئِلتُ في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة، وذلك في السنة الخامسة من الحرب العالمية: ما السبب في هذه المجاعة وفي ضياع المال وفي مشقة الأجساد التي أصابت المسلمين؟
فقلت في تلك الرؤيا:
146. صفحة
إن الله تعالى قد طلب منا فيما أعطى لنا من ماله العشر([1]) في بعض الأموال، وواحدا من أربعين[2] في بعضها الآخر، حتى يُكسبنا أدعيةَ الفقراء، ويصرف عنا حقدهم وحسدهم، إلا أننا طمعْنا بسبب حرصنا ولم نعطها، فالله تعالى أخذ الزكاة المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين، وبنسبة ثمانية من عشرة.
وكذا طلب منا في شهر واحد من كل سنة أن نجوع جوعا يتضمن سبعين حكمة، ولكننا أشفقنا على أنفسنا ولم نتحمل الجوع المؤقت الحلو اللذيذ، فأرغمنا الحق تعالى -عقابا لنا- على نوع من الصوم له سبعون وجها من المصائب لمدة خمس سنوات.
وكذا طلب منا ساعة واحدة من بين أربع وعشرين ساعة، أي نوعا من تدريبات ربانية حلوة سامية نورانية وذات فوائد، فتكاسلنا ولم نؤدّ تلك الصلاة والعبادة، فأضعنا تلك الساعة الواحدة مع بقية الساعات، فأرغمنا الحق تعالى – كفارة عن ذلك - على أداء نوع من الصلاة بالتدريب والعمل الشاق طوال خمس سنوات.
قلت ذلك ثم أفقت، ففكرت في هذا، وفهمت أن في تلك الرؤيا الخيالية حقيقةً مهمةً للغاية كما بُيِّن وأثبت في "الكلمة الخامسة والعشرين" عند عقد المقارنة بين الحضارة الحديثة وأحكام القرآن من أن منشأ جميع الأخلاق السيئة وجميع الاختلالات في الحياة الاجتماعية البشرية كلمتان:
أولاهما: إذا شبعتُ أنا فما لي إن مات غيري من الجوع؟!
ثانيتهما: اعمل أنت لآكل أنا.
وأن الذي يديم هاتين الكلمتين هو جريان الربا وترك الزكاة.
وأن العلاج الوحيد الذي يداوي هذين المرضين الاجتماعيين الخطيرين هو وجوب الزكاة مع تطبيقها كدستور شامل، وتحريم الربا؛ إذ الزكاة ليست أهم ركن لسعادة حياة الأفراد والمجتمعات الخاصة فحسب، بل لسعادة الحياة البشرية، بل هي أهم ركن لإدامة الحياة الإنسانية؛ إذ البشرية فيها طبقتان: الخواص والعوام، والزكاة هي التي تؤمن الرحمة والإحسان من الخواص تجاه العوام وتؤمن الاحترام والطاعة من العوام
[1] أي العشر من أمواله التي يمنحها طازجة كل سنة كالقمح.(المؤلف).
[2] أي واحدا من أربعين من المال الذي أعطاه سابقا؛ بحيث يعطي من تلك الأربعين كل سنة - غالبا وعلى الأقلّ - عشرة طازجة جديدة من حيث الربح التجاري وتولد المواشي.(المؤلف).
147. صفحة
تجاه الخواص؛ وإلا فسينهال الظلم والتحكم من الأعلى على رءوس العوام، وسيصعد من العوام الحقد والعصيان تجاه الأغنياء، وتظل هاتان الطبقتان من البشر في صراع معنوي دائم وفي خلافات مضطربة دائمة، هكذا يستمر الحال شيئا فشيئا حتى تشتبكان وتتجابهان في صورة صراع العمل ورأس المال كما حدث في روسيا.
فيا أهل الكرم، ويا أصحاب الضمائر الحية، ويا أهل السخاء والإحسان! إن لم يكن الإحسانُ باسم الزكاة فله ثلاثة أضرار، بل يذهب دون فائدة أحيانًا، لأنك تَمُنُّ على الفقير المسكين - معنىً - إذ إنك لا تعطيه في سبيل الله، فتضعه تحت أسر المنة، وتبقى محروما من دعائه الخالص المقبول، فضلا عن أنك تكفر بالنعمة؛ إذ تظن أنك صاحب المال مع أنك في الحقيقة لست إلا موظف توزيع أموال الحق تعالى على عباده، ولكنك إن أعطيت باسم الزكاة؛ فإنك تكسب ثوابا لأنك أعطيته في سبيل الله تعالى، وتبدي شكرا للنعم، فذلك الرجل المحتاج لم يكن مضطرًّا إلى التطلع لك، فلا تنكسر عزة نفسه، ويكون دعاؤه لك دعاءا مقبولاً.
نعم؛ فأين اكتساب أضرار كالرياء والشهرة وكالمنة والإذلال بإعطاء بقدر الزكاة، وبإعطاء بإحسان أو بطرق أخرى نافلةً أكثر منها؛ من أداء فرض بإعطاء ذلك الإحسان باسم الزكاة، بل من اكتساب الثواب والإخلاص والدعاء المقبول؟! شتَّان ما بينهما!
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي قال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"([1]) وقال: "القناعة كنز لا يفنى"([2]) وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.
والحمد لله ربّ العالمين.
[1] الحديث في صحيح البخاري رقم ٤٦٧، ك الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
[2] جاء في مرقاة المفاتيح أنه حديث بالنص المذكور، وفي المعجم الأوسط للطبراني برقم ٦٩٢٢، بنص :"عليكم بالقناعة فإن القناعة مال لا ينفد".
148. صفحة
خاتمة
حول الغيبة
باسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده
لم يَدَعْ تنفيرُ آية واحدة من الغيبة بإعجاز في وجوه ستة -هذه الآية التي هي من أمثلة مقام الذم والزجر في النقطة الخامسة من الشعاع الأول من الشعلة الأولى للكلمة الخامسة والعشرين- حاجةً لبيان آخر؛ إذ بيَّنَت تلك الآية بيانا وافيًا مدى شناعة الغيبة في نظر القرآن الكريم، أجل؛ فليس بعد بيان القرآن بيانٌ، ولا حاجة إلى غيره.
ففي ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ (الحجرات:١٢) يذم الذمّ في ست درجات، ويزجر عن الغيبة بشدة في ست مراتب، فهذه الآية عندما تكون متوجِّهة بالفعل إلى المغتابين فيكون معناها كما يلي:
من المعلوم أن الهمزة التي في أول الآية الكريمة للاستفهام بمعنى (أيَا)، وهذا الاستفهام يسري معناه كالماء في جميع كلمات الآية، ففي كل كلمة حُكمٌ ضمني.
فأولا: تقول الآية الكريمة بالهمزة: أليس لكم العقل الذي هو محل السؤال والجواب حتى لم يعُد يدرك شيئا شنيعا إلى هذه الدرجة؟
وثانيا: تقول بلفظ ﴿يُحِبُّ﴾: أَفَسد قلبُكم الذي هو محل الحب والبغض، فأصبح يحب أبغض الأشياء؟
وثالثا: تقول بكلمة ﴿أَحَدُكُمْ﴾: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية والمدنية التي تستمد حياتها من الجماعة، حتى أصبحتا تَقْبَلاَنِ عملا كهذا الذي يسمم حياتكم؟
ورابعا: تقول بعبارة ﴿أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ﴾: ماذا أصاب إنسانيتكم حتى أصبحتم تمزِّقون بوحشية صديقَكم بأسنانكم؟
وخامسا: تقول بلفظ ﴿أخيه﴾ أليس لديكم رأفة ببني جنسكم، وأليست لكم صلة رحم بهم، حتى أصبحتم تَقْضِمُون - بدون إنصاف - الشخص المعنوي لذلك
149. صفحة
لذلك المظلوم الذي هو أخوكم من وجوه كثيرة، وألم يكن لكم عقل حتى تنهشون أعضاءكم بأسنانكم كالمجانين.
وسادسا: تقول بكلمة ﴿مَيْتًا﴾: أين ضميركم؟ هل فسدتْ فطرتكم حتى تقومون بأشنع الأشياء وهو أكل لحم أخيكم الذي هو جدير بكل الاحترام؟
إذن يُفهَم من تعبير هذه الآية الكريمة ومن دلالات كلماتها - كل على حدة - أن الذم والغيبة مذمومان عقلاً وقلبًا وإنسانيةً ووجدانًا وفطرةً وملّةً.
فانظر كيف أنها تزجر عن تلك الجريمة بإعجاز في ست درجات بذمِّها الذَّمَّ بإيجاز في ست مراتب، فالغيبة هي أكثر الأسلحة الدنيئة التي يستعملها أصحاب العداء والحسد والعناد، فصاحب النفس العزيزة يأنف من استعمال هذا السلاح القذر.
وكما قال أحد المشهورين:
وأُكبرُ نَفْسِي عَنْ جَزَاءٍ بِغِيْبَةٍ فَكُلُّ اغْتِيَابٍ جَهْدُ مَنْ لاَ لَهُ جَهْدٌ([1])
أي: أكبر نفسي عن جزاء عدوي بغيبة، ولا أنزل لفعل ذلك؛ لأن الغيبة هي سلاح الضعفاء والأذلاء والدنيئين.
والغيبة هي: ما إذا سمعه المغتاب في حقه كرهه وغضب منه، فلئن كانت الغيبة التي قيلت في حقه صحيحة فهي غيبة أصلا، وإن كانت كذبا فهي غيبة، وفي الوقت نفسه افتراء، وإثم مضاعف مشين.
إلا أن الغيبة يمكن أن تكون جائزة في بعض الأحوال المعيَّنة:
إحداها: أن يشكو المرء أحدَهم لموظف حتى يُعِينَه فيزيل عنه ذلك الخطأ والمنكَر، ويأخذ حقه منه.
ومنها: هناك من يريد أن يشترك مع شخص في عمل فيشاورك في هذا الأمر، فإن أنت قلت له من أجل المصلحة فقط، ودون أن يداخلك حقد شخصي وعداوة، ومن أجل أداء حق المشورة فحسب: "لا تتعامَل معه؛ لأنك ستخسر وتتضرر من ذلك"؛ فلا غيبة في ذلك.
ومنها: أن يُقال عن أحدهم لا لغرض التحقير والتشهير بل للتعريف: ذهب ذلك الرجل المتسكع الأعرج إلى المكان الفلاني.
[1])) البيت للمتنبي.
150. صفحة
ومنها: أن يكون المغتاب فاسقا مجاهرا؛ أي لا يخجل من الفسق، بل يفتخر بما يرتكب من سيئات، ويتلذذ بظلمه، ويرتكب ذلك الفسق دون تورع أو خجل عيانًا جهارًا.
فيمكن أن تجوز الغيبة في هذه الحالات الخاصة المحددة من أجل الحق والمصلحة فقط، من دون أن يتدخل حقد أو غضب شخصي، وإلا فالغيبة تأكل الأعمال الصالحة وتُحْبِطُها كما تأكل النار الحطب وتأتي عليه.
فإذا اغتاب المرء أو استمع إلى الغيبة برغبة منه، فعليه أن يدعو ويقول "اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِمَن اغْتَبْنَاهُ"، ثم عليه أن يقول لمن اغتابه متى ما التقاه "سامحني، واجعلني في حِلٍّ من حقك".
الباقي هو الباقي