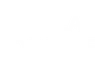سورة البقرة-7
التنقل
79. صفحة
﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
مقدمة
اعلم أنه لزمَنا أن نقف هنا حتى نستمع لما يتكلم به المتكلمون؛ إذ تحت هذه الآية حرب عظيمة بين أهل الاعتزال وأهل الجبر وأهل السنة والجماعة، ومثلُ هذه الحرب تستوقف النُظّار، فناسب أن نذكر أساساتٍ لتستفيد منها:
إن مذهب أهل السنة والجماعة هو الصراط المستقيم، وماعداه؛ إما إفراط، أو تفريط.
منها: أنه قد تحقق "ألا مُؤَثِّرَ فِي الْكَوْنِ إلاّ الله" فإذًا لا تفويض([1]).
ومنها: "أن الله حكيم" فلا يكون الثواب والعقاب عبثَيْن فحينئذ لا اضطرار، فكما أن التوحيد يدفع في صدر الاعتزال؛ كذلك التنزيه يضرب على فم الجبر.
ومنها: أن لكل شيء جهتين: جهةٌ مُلكيةٌ هي قد تكون حسنةً وقد تكون قبيحة تتوارد عليها الأشكال كظهر المرآة، وجهة ملكوتية تنظر إلى الخالق، وتلك شفافة في كل شيء كوجه المرآة، فخلقُ القبيح ليس قبيحًا؛ إذ الخلق من جهة الملكوتية حسن، ولأن خلقه لتكميل المحاسن فيحسن بالغير، فلا تصغ إلى سفسطة الاعتزال.
ومنها: أن الحاصل بالمصدر([2]) أمر قارٌّ مخلوق جامد لا يشتق منه الصفات([3])، وأما المصدر فمكسوب نسبيّ اعتباريّ يشتق منه الصفات، فلا يكون خالق القتل قاتلا، فَذَرْ أهل الاعتزالِ في خوضهم يَلْعَبُون.
([1]) كما يقول أهل الاعتزال من أن العبد خالق لأفعاله. (ت: 79) ([2])كالألم والموت الحاصلين بالضرب والقتل. (ت: 79) ([3]) أي لا يشتق من الجامد اسم الفاعل كما هو معلوم في علم الصرف. (ت: 80)
80. صفحة
ومنها: أن الفعل الظاهريّ في الأغلب نتيجةٌ لأفعال متسلسلة منتهية إلى ميلان النفس الذي يسمّى "بالجزء الاختياري"، فتدور المنازعات على هذا الأساس.
ومنها: أن الإرادة الكلية الإلهية ناظرة بعادته تعالى إلى الإرادة الجزئية للعبد، فلا اضطرار.
ومنها: أن العلم تابع للمعلوم، فلا يتبعه المعلوم حتى يدور، فلا يُتعلل في العمل بإحالة مقاييسه على القدر.
ومنها: أن خلق الحاصل بالمصدر متوقفٌ على كسب المصدر بجريان عادة الله تعالى باشتراطه به، والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية فيه هي الميلان، فبحلّه تنحل عقدة المسألة.
ومنها: أن الترجُّح بلا مرجِّحٍ محالٌ دون الترجيح بلا مرجِّح فلا تُعلّلُ أفعالُه تعالى بالأغراض؛ بل اختياره تعالى هو المرجِّح.
ومنها: أن الأمر الموجود لابد له من مؤثر، وإلا لزم الترجح بلا مرجح وهو محال كما مر، وأما الأمر الاعتباري([1]) فتخصصه بلا مخصص لا يلزم منه المحال.
ومنها: أن الموجود يجب أن يجب ثم يوجد([2])، وأما الأمر الاعتباري فالترجُّح بلا انتهاء إلى حد الوجوب كاف فلا يلزم ممكن بلا مؤثر.
ومنها: أن العلم بوجود شيء لا يستلزم العلمَ بماهيته، وعدمُ العلم بالماهية لايستلزم العدم، فعدم التعبير عن كُنهِ الاختيار لا ينافي قطعية وجوده.
وإذا تفطنت لهذه الأساسات فاستمع لما يُتلى عليك:
فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول: يا أهل الاعتزال، إن العبد ليس خالقًا للحاصل بالمصدر كالحاصل من المصدر([3])، بل هو مصدر المصدر فقط([4])؛ إذ "لا مؤثر في الكون إلا الله"، والتوحيد هكذا يقتضي.
([1]) هو الذي لا وجود له إلاّ في عقل المعتبر مادام معتبرًا، وهو الماهية بشرط العراء، انظر التعريفات: 54. ([2]) أي لا يأتي إلى الوجود شيء ما لم يكن وجوده واجبًا، فعند تعلق الإرادتين الجزئية والكلية في شيء يكون وجود الشيء واجبًا، فيوجد حالا (ت: 80) ([3]) أي ليس خالقًا للأثر الحاصل بالمصدر، وهو الذي يطلق عليه الكسب (ت: 81) ([4]) فليس بيد العبد إلاّ الكسب (ت: 81)
81. صفحة
ثم نقول: يا أهل الجبر، ليس العبد مضطرًا بل له جزء اختياري؛ لأن الله حكيم، وهكذا يقتضي التنزيه.
فإن قلتم: كلما يُشرّح الجزء الاختياري بالتحليل لا يظهر منه إلا الجبر.
قيل لكم:
أولا: إن الوجدان والفطرة يشهدان أنَّ بينَ الأمرِ الاختياري والاضطراري أمرًا خفيًّا فارقا، وجودُه قطعي، فلا علينا أن لا نعبِّر عنه.
وثانيًا: نقول: إن الميلان إن كان أمرًا موجودًا -كما عليه الأشاعرة([1])- فالتصرف فيه أمرٌ اعتباري بيد العبد([2])؛ وإن كان الميلان أمرًا اعتباريا -كما عليه الماتريدية([3])- فذلك الأمر الاعتباري ثبوتُه وتخصُّصه لا يستلزم العلة التامة([4]) الموجبة([5]) فيجوز التخلف([6])، فتأمل.
والحاصل: أن الحاصل بالمصدر موقوفٌ عادةً على([7]) المصدر الذي أساسه الميلان الذي هو -أو التصرف فيه- ليس موجودًا حتى يَلزم([8]) من تخصصه مرة هذا ومرة ذاك ممكن بلا مؤثر، أو ترجّحٌ بلا مرجِّح، ولا معدومًا أيضًا حتى لا يصلح أن يكون شرطا لخلق الحاصل بالمصدر أو سببًا للثواب والعقاب.
([1]) هي مدرسة فكرية إسلامية سنية ذات منهج كلامي اتخذ منهجا في العقيدة، أساسه تأويل صفات الله تعالى، وفق مقتضى اللغة، لتنزيهه عن مشابهة خلقه، وينسبون لأبي الحسن الأشعري، صاحب كتاب الإبانة، انظر: الفرق الإسلامية للدكتور مزروعة 147-162. ([2]) أي: تحويل ذلك الميلان من فعل إلى آخر (ت: 81) . ([3]) هي فرقة من الفرق الإسلامية تحقق العقيدة بالأدلة العقلية مسترشدة بالأدلة النقلية وإمامها أبو منصور محمد الماتريدي المتوفى 333 هـ، انظر: الفرق الإسلامية للدكتور مزروعة 163 وما بعدها. ([4]) العلة التامة: هي ما يجب وجود المعلول عندها، وقيل العلة التامة جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء وقيل هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء بمعنى أنه لا يكون وراءه شيء يتوقف عليها، انظر: التعريفات: 201، والتوقيف على مهمات التعاريف 523. ([5]) بحيث لا تبقى الحاجة إلى الإرادة الكلية (ت: 81) ([6]) إذ كثيرًا لا يقع الفعل بوقوع الميلان (ت: 81) ([7]) على عادة الله الجارية (ت: 81) ([8]) فيحتاج إلى مؤثر (ت: 81)
82. صفحة
إن قلت: العلم الأزلي والإرادة الأزلية يَنْحَيَان على الاختيار بالقلع؟
قيل لك: إن العلم بفعلٍ باختيارٍ لا ينافي الاختيار([1]).
وأيضًا إن العلم الأزلي محيط كالسماء لا مبدأ للسلسلة كرأس زمان الماضي حتى تسند إليه المسبَّبات متغافلا عن الأسباب موهما خروجها.
وأيضًا إن العلم تابع للمعلوم، أي: على أي كيفية يكون المعلوم، كذلك يحيط به العلم، فلا تستند مقاييس المعلوم إلى أساسات القدر.
وأيضًا إن الإرادة لا تتعلق بالمسبَّب فقط مرة وبالسبب مرة أخرى حتى لا تبقى فائدة في الاختيار والسبب؛ بل تتعلق تعلقًا واحدًا بالمسبب وبسببه.
وعلى هذا السر لو قتل شخص شخصًا بالبندقة مثلا، ثم فرضنا عدم السبب والرمي هل يموت ذلك الشخص في ذلك الآن أم لا؟
فأهل الجبر يقولون: لو لم يُقتل لمات أيضًا لتعدد التعلق والانقطاع بين السبب والمسبب.
وأهل الاعتزال يقولون: لم يمت، لجواز تخلف المراد عن الإرادة عندهم.
وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: نتوقف ونسكت؛ إذ فرض عدم السبب يستلزم فرض عدم تعلق الإرادة والعلم بالمسبب أيضًا؛ إذ التعلق واحد، فهذا الفرض المحال جاز أن يستلزم محالا، فتأمل.
مقدمة أخرى
اعلم أن الطبيعيين([2]) يقولون: إن للأسباب تأثيرًا حقيقيًّا.
والمجوس([3]) يقولون: ان للشر خالقًا آخر.
والمعتزلة يدّعون: أن الحيوان خالق لأفعاله الاختيارية.
([1]) لأن المؤثر هو القدرة وليس العلم الذي هو تابع للمعلوم (ت: 82) ([2]) الذين يعبدون الطبيعة، انظر: الملل والنحل 2/3. ([3]) المجوس: هم عُبَّاد الشمس والقمر والنار، وأطلق عليهم ذلك اللقب منذ القرن الثالث للميلاد، انظر: الملل والنحل 1/265، والمعجم الوسيط: (مـ - ج – س) 2/855.
83. صفحة
وأساس هذه الثلاثة مبنية على وهمٍ باطلٍ، وخطأ محض، وتجاوز عن الحد، وقياس مع الفارق، خدعهم وشبَّطهم؛ إذ ذهبوا ظنًا منهم إلى التنزيه فوقعوا في شَرَك الشِرك، وإن شئت التفصيل فاستمع لمسائل تطرد ذلك الوهم:
منها: أنه كما أن استماع الإنسان وتكلمه وملاحظته وتفكره جزئية تتعلق بشيء فشيء على سبيل التعاقب؛ كذلك همَّتُه جزئية لا تشتغل بالأشياء إلا على سبيل التناوب.
ومنها: أن قيمة الإنسان بنسبة ماهيته، وماهيته بدرجة همته، وهمته بمقدار أهمية المقصد الذي يشتغل به.
ومنها: أن الإنسان إلى أي شيء توجَّه يفنى فيه وينحبس عليه، ومن هذه النقطة ترى الناس -في عرفهم- لا يُسنِدون شيئا خسيسًا وأمرًا جزئيا إلى شخص عظيم وذاتٍ عال؛ بل إلى الوسائل ظنًّا منهم أن الاشتغال بالأمر الخسيس لا يناسب وقاره، وهو لا يتنزل له، ولا يسع الأمر الحقير همته العظيمة، ولا يوازن الأمر الخفيف مع همته العظيمة.
ومنها: أن من شأن الإنسان -إذا تفكر في شيء لمحاكمة([1]) أحواله- أن يتحرى مقاييسه وروابطه وأساساته، أولا في نفسه، ثم في أبناء جنسه، وإن لم يجد ففي جوانبه من الممكنات، حتى إن واجب الوجود الذي لا يشبه الممكنات بوجه من الوجوه إذا تفكر فيه الإنسان تلجؤه القوة الواهمة لأن يجعل هذا الوهم السيء المذكور دستورًا، والقياس الخادع منظارًا له، مع أن الصانع جل جلاله لا ينظر إليه من هذه النقطة؛ إذ لا انحصار لقدرته.
ومنها: أن قدرته وعلمه وإرادته جل جلاله كضياء الشمس -ولله الْمَثَلُ الأعْلى- شاملة لكل شيء، وعامة لكل أمر، فلا تقع في الانحصار ولا تجيء في الموازنة، فكما تتعلق بأعظم الأشياء كالعرش؛ تتعلق بأصغرها كالجوهر الفرد([2])، وكما خلق الشمس والقمر؛ كذلك خلق عينَي البرغوث والبعوضة، وكما أودع نظامًا عاليًا في
([1]) المحاكمة هنا استخدام تركي بمعنى التدبر والحكم على الشيء. ([2]) الجوهر الفرد: هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة، انظر: معجم مقاليد العلوم 72، والحدود الأنيقة 71.
84. صفحة
الكائنات؛ كذلك أوقع نظامًا دقيقًا في أمعاء الحيوانات الخردبينية([1])، وكما ربط الأجرام العلوية والنجوم المعلَّقة بقانونه المسمى بالجاذب العمومي؛ كذلك نظّم الجواهر الفردة بنظير ذلك القانون كأنه مثال مصغر لها؛ إذ بتداخل العجز تتفاوت مراتب القدرة، فمن امتنع عليه العجزُ تتساوى في قدرته الأشياء؛ إذ العجز ضد القدرة الذاتية، فتأمل.
ومنها: أن أول ما تتعلق به القدرة ملكوتية الأشياء، وهي شفّافة حسنة في الكل كما مر، فكما أنه جل جلاله جعل وجه الشمس مجلىً ووجه القمر مستضيئا؛ كذلك صير ملكوتية الليل والغيم حسنة منيرة.
ومنها: أن مقياس عظمته تعالى وميزان كمالاته وواسطة محاكمة أوصافه لا يسعها ذهنُ البشر، ولا يمكن له بوجه، بل إنما هو بما يتحصل من جميع مصنوعاته، وبما يتجلى من مجموع آثاره، وبما يتلخص من كل أفعاله.
نعم؛ الذرة تكون مرآةً ولا تكون مقياسًا.
وإذا تفطنت لهذه المسائل فاعلم أن الواجب تعالى([2]) لا يقاس على الممكنات؛ إذ الفرق من الثرى إلى الثريا، ألا ترى أهل الطبيعة والاعتزال والمجوس -بناء على تسلط القوة الواهمة بهذا القياس على عقولهم- كيف التجأوا إلى إسناد التأثير الحقيقي إلى الأسباب، وخلق الأفعال للحيوان، وخلق الشر لغيره تعالى؟! يظنون ويتوهمون أن الله تعالى بعظمته وكبريائه وتنزّهه كيف يتنزل لهذه الأمور الخسيسة والأشياء القبيحة؟ فسحقًا لهم! كيف صيروا العقل أسيرًا لهذا الوهم الواهي هـذا؟!
يا هذا، هذا الوهم قد يتسلط على المؤمن أيضًا من جهة الوسوسة، فتجنَّب!
أما تحليل كلمات هذه الآية ونظمها:
فاعلم أن ربط ﴿خَتَمَ﴾ بـ ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ وتعقيبه به نظير ترتب العقاب على العمل، كأنه يقول: لما أفسدوا الجزء الاختياري ولم يؤمنوا عوقبوا بختم القلب وسدّه.
([1]) كلمة فارسية تعني الأشياء الدقيقة الصغيرة، انظر: المعجم الفارسي العربي الموجز 121. ([2]) اختصار لواجب الوجود.
85. صفحة
ثم لفظ "الختم" يشير إلى استعارة مركبة([1]) تومئ إلى أسلوب تمثيلي يرمز إلى ضربِ مَثَلٍ يصوِّر ضلالتهم؛ إذ المعنى فيه منع نفوذ الحق إلى القلب، فالتعبير بالختم يصور القلب بيتًا بناه الله تعالى ليكون خزانة الجواهر، ثم بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار ما فيه سموما، فأُغلق وأُمهر ليُجتنب.
وأما ﴿اللَّهُ﴾ فاعلم أن فيه التفاتًا من التكلم إلى الغيبة، ومع نكتة الالتفات ففي مناسبة لفظ ﴿اللَّهُ﴾ مع متعلق ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ في النية، أعني لفظ بـ﴿اللَّهُ﴾، إشارة إلى لطافة، هي أنه لما جاء نور معرفة الله إليهم فلم يفتحوا باب قلبهم له، تولى عنه مغضبًا وأغلق الباب عليهم.
وأما ﴿عَلَى﴾ فاعلم أن فيه -بناء على كون الختم متعديًا بنفسه- إشارة إلى تضمين([2]) ﴿خَتَمَ﴾ "وَسَمَ"، كأنه يقول: جعل الله الختم وسمًا وعلامةً على القلب يتوسمه الملائكة.
وفي ﴿عَلَى﴾ أيضًا إيماء إلى أن المسدود الباب العلوي من القلب لا الباب السفلي الناظر إلى الدنيا.
وأما ﴿قُلُوبِهِمْ﴾ قدّمه على السمع والبصر لأنه هو محل الإيمان، ولأن أول دلائل الصانع يتجلى من مشاورة القلب مع نفسه، ومراجعة الوجدان إلى فطرته؛ لأنه إذا راجع نفسه يحس بعجز شديد يُلجِئُه إلى نقطة استناد، ويرى احتياجًا شديدًا لتنمية آماله، فيضطر إلى نقطة استمداد، ولا استناد ولا استمداد إلا بالإيمان.
ثم إن المراد بالقلب اللطيفة الربانية التي مظهر حسيّاتها الوجدان، ومعكس أفكارها الدماغ، لا الجسم الصنوبري، فإذًا في التعبير بالقلب رمز إلى ان اللطيفة الربانية لمعنويات الإنسان كالجسم الصنوبري لجسده، فكما أن ذلك الجسم
([1]) وهي المجاز المركب كما سماها القزويني المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : تمثيلية ومرشحة ومجردة، والتمثيلية -وهي التي هنا- تركيب استعمل في غير ما وضع له بعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، انظر: الإيضاح في علوم البلاغة 284، ومعجم المصطلحات البلاغية 1/156. ([2]) يقصد ضمن معنى كلمة (ختم) فعلا آخر هو (وسم) ولذلك قال ختم على، والتضمين هو أن يوقع لفظا موقع غيره ويعامله معاملته لتضمنه معناه واشتماله عليه.
86. صفحة
ماكينة حياتية تنشر ماء الحياة لأقطار البدن، وإذا انسد وسكن جمد الجسد؛ كذلك تلك اللطيفة تنشر نور الحياة الحقيقية لأقطار الهيئة المجسمة من معنوياته وأحواله وآماله، وإذا زال نور الإيمان -العياذ بالله- صارت ماهيته التي يصارع بها الكائنات كشبحٍ لا حِرَاكَ به، وأظلم عليه.
وأما ﴿وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ كرر ﴿عَلَى﴾ للإشارة إلى استقلال كلٍّ بنوع من الدلائل، فالقلب بالدلائل العقلية والوجدانية، والسمع بالدلائل النقلية والخارجية، وللرمز إلى أن خَتْمَ السمع ليس من جنس ختم القلب.
ثم إن في إفراد السمع مع جمع جانبيه([1]) إيجازًا ورمزًا إلى أن السمع مصدر، لعدم الجمع له، وإلى أن المُسمِع فرد، وأن المسموع للكل فرد، وأنه يسمع فردًا فردًا، ولاشتراك الكل كأن أسماعهم بالاتصال صارت فردًا، ولاتحاد الجماعة وتشخصها يتخيل لها سمع فرد، وإلى إغناء سمع الفرد عن استماع الكل، فحق السمع في البلاغة الإفراد، لكن القلوب والأبصار مختلفة متعلقاتهما، ومتباينة طرقهما، ومتفاوتة دلائلهما، ومعلمهما على أنواع، وملقّنهما على أقسام، فلهذا توسط المفرد بين الجمعين، وعقّب القلب بالسمع لأن السمع أبٌ لملكاته[2]، وأقرب إليه، ونظيره في تساوي الجهات الست عنده([3]).
وأما ﴿وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ فاعلم أن في تغيير الأسلوب باختيار الجملة الاسمية إشارة إلى أن جنانَ البصر التي يجتني منها دلائله ثابتة دائمة بخلاف حدائق السمع والقلب؛ فإنها متجددة، وفي إسناد الختم إلى الله تعالى دون الغشاوة إشارة إلى أن الختم جزاء كسبهم، والغشاوة مكسوبة لهم، ورمز إلى أن في مبدأ السمع والقلب اختيارًا، وفي مبدأ البصر اضطرارًا ومحل الاختيار غشاوة التعامي، وفي
([1]) أي القلوب والأبصار.
[2] الملكة: صفة راسخة للنفس، وتحقيقه أنه يحصل في النفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارست النفس حتى ترسخ تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا، انظر التعريفات296، والتعاريف675.
([3]) وهذا تعبير دقيق من المؤلف رحمه الله؛ لأن الإنسان يسمع من جميع الجهات لكنه لا يبصر إلا من أمامه فقط.
87. صفحة
عنوان الغشاوة([1]) إشارة إلى أن للعين جهة واحدة، وتنكيرها للتنكير، أي: التعامي حجاب غير معروف حتى يُتَحفظ منه، قدّم ﴿عَلَى أَبْصَارِهِمْ﴾ ليوجه العيون إلى عيونهم؛ إذ العين مرآة سرائر القلب.
وأما ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فاعلم أنه كما أشار بالكلمات السابقة إلى حنظلات تلك الشجرة الملعونة الكفرية في الدنيا؛ كذلك أشار بهذه إلى حنظلة جانبها الممتد إلى الآخرة، وهي زقّوم جهنّم.
ثم إن سجية الأسلوب تقتضي (وعليهم عقاب شديد) ففي إبدال "على" بـ"اللام"، و"العقاب" بـ"العذاب"، و"الشديد" بـ"العظيم"، مع أن كلا منها يليق بالنعمة، رمز إلى نوعِ تهكم توبيخيّ تعريضيّ؛ كأنه ينعي بهم: ما منفعتهم، ولا لذتهم، ولا نعمتهم العظيمة إلا العقاب؛ نظير: (تَحِيَّةُ بَيْنهمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ)([2])، و﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ ألِيمٍ﴾([3]) إذ اللام لعاقبة([4]) العمل وفائدته، فكأنه يتلو عليهم "خذوا أجرة عملكم".
وفي لفظ الـ﴿عَذَاب﴾ رمز خفي إلى أن يذكرهم استعذابهم واستلذاذهم بالمعاصي في الدنيا، فكأنه يقرأ عليهم "ذوقوا مرارة حلاوتكم".
وفي لفظ الـ ﴿عَظِيمٌ﴾ إشارة خفية إلى تذكيرهم حال صاحب النعمة العظيمة في الجنة، فكأنه يلقنهم: انظروا إلى ما ضيعتم على أنفسكم من النعمة العظيمة، وكيف وقعتم في الألم الأليم.
ثم إن ﴿عَظِيمٌ﴾ تأكيد لتنوين ﴿عَذَاب﴾.
إن قلت: إن معصية الكفر كانت في زمان قليل، والجزاء أبديّ غير متناه، فكيف ينطبق هذا الجزاء على العدالة الإلهية؟
([1]) أي: لفظ الغشاوة.
([2]) هذا عجز بيت لعمرو بن معد يكرب موجود في ديوانه 149 وصدره، وخيل قد دلفت لها بخيل ... وصار يضرب به المثل في التهكم ،انظر: الخصائص1/368،والممتع 260، وخزانة الأدب 9/252.
([3]) سورة آل عمران 21 .
([4]) لام العاقبة هي إحدى اللامات، وهي التي يسميها الكوفيون لام الصيرورة؛ ومنها قول الشاعر:
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
انظر: اللامات للزجاجي: 119 – 121.
88. صفحة
وإنْ سُلِّم، فكيف يوافق الحكمة الأزلية؟
وإن سُلِّم، فكيف تساعده المرحمة الربانية؟
قيل لك: مع تسليم عدم تناهي الجزاء، إن الكفر في زمان متناهٍ جناية غير متناهية بست جهات:
منها: أن من مات على الكفر لو بقي أبدا لكان كافرًا أبدًا لفساد جوهر روحه، فهذا القلب الفاسد استعدَّ لجناية غير متناهية.
ومنها: أن الكفر وإنْ كان في زمان متناه لكنه جناية على غير المتناهي، وتكذيب لغير المتناهي أعني عموم الكائنات التي تشهد على الوحدانية.
ومنها: أن الكفر كفرانٌ لنعمٍ غير متناهية.
ومنها: أن الكفر جناية في مقابلة غير المتناهي وهو الذات والصفات الإلهية.
ومنها: أن وجدان البشر -بسر حديث "لاَ يَسَعُني أرضي وَلا سَمائي"([1])- وإن كان في الظاهر والملك محصورًا ومتناهيًا لكن ملكوتيته بالحقيقة نشرت ومدت عروقها إلى الأبد، فهو من هذه الجهة كغير المتناهي وبالكفر تلوث واضْمَحَلَّ.
ومنها: أن الضدَّ وإن كان معاندًا لضده لكنه مماثل له في أكثر الأحكام، فكما أن الإيمان يثمر اللذائذ الأبدية، كذلك من شأن الكفر أن يتولد منه الآلام الأبدية.
فمن مزج هذه الجهات الست يستنتج أن الجزاء غير المتناهي إنما هو في مقابلة الجناية غير المتناهية، وما هو إلاّ عين العدالة.
إن قلت: طابَقَ العدالةَ، لكن أين الحكمة الغنية عن وجود الشرور المنتجة للعذاب؟
([1]) الحديث "ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن"، ذكره في الإحياء بلفظ مقارب، قال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلا، انظر كشف الخفاء للعجلوني 2/195 باختصار (وقال السيوطي في الدرر المنتثرة: قلت أخرج الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه: إن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يارب! فقال الله: إن السموات والأرض ضعفن أن يسعنني ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين) ا.هـ. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية: وذكرُ جماعةٍ له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلاًّ منهما كفر، وصالحو الصوفية أعرف الناس بالله، وما يجب له وما يستحيل عليه، وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الإيمان بالله ومحبته ومعرفته. ا هـ .
89. صفحة
قيل لك: كما قد سمعت مرة أخرى أنه لا يُترك الخير الكثير لتخلل الشر القليل لأنه شر كثير؛ إذ لما اقتضت الحكمة الإلهية تَظَاهُرَ ثبوت الحقائق النسبية التي هي أزيد بدرجات من الحقائق الحقيقية ولا يمكن هذا التظاهر إلا بوجود الشرِّ؛ ولا يمكن توقيف الشر على حدّه، ومنع طغيانه إلا بالترهيب؛ ولا يمكن تأثير الترهيب حقيقة في الوجدان إلا بتصديق الترهيب وتحقيقه بوجود عذاب خارجي؛ إذ الوجد ألا يتأثر حق التأثر -كالعقل والوهم- بالترهيب إلا بعد أن يَتَحَدَّسَ بالحقيقة الخارجية الأبدية بتفاريق([1]) الأمارات فمن عين الحكمة بعد التخويف من النار في الدنيا وجود النار في الآخرة.
إن قلت: قد وافق الحكمةَ فما جهة المرحمة فيه؟
قلت: لا يتصور في حقهم إلاّ العدم أو الوجود في العذاب، والوجود -ولو في جهنم- مرحمةٌ وخيرٌ بالنسبة إلى العدم إن تأملت في وجدانك؛ إذ العدم شرٌّ محض، حتى إن العدم مرجع كل المصائب والمعاصي إنْ تَفَكَّرْتَ في تحليلها، وأما الوجود فخير محض فليكن في جهنم.
وكذا إن من شأن فطرة الروح -إذا علم أن العذاب جزاء مزيل لجنايته وعصيانه- أن يرضى به لتخفيف حمل خجالة الجناية، ويقول: هو حق، وأنا مستحقٌّ، بل حبًّا للعدالة قد يلتذ معنى، وكم من صاحب ناموس[2] في الدنيا يشتاق إلى إجراء الحد على نفسه ليزول عنه حجاب خجالة الجناية.
وكذا إن الدخول وإن كان إلى خلود دائم وجهنم بيتهم أبدا، لكن بعد مرور جزاء العمل دون الاستحقاق يحصل لهم نوع ألفة وتطبّع مع تخفيفات كثيرة مكافأةً لأعمالهم الخيرية، أشارت إليها الأحاديث([3])، فهذا مرحمة لهم مع عدم لياقتهم.
([1]) التفاريق: أجزاء الشيء المتفرقة، انظر: المعجم الوسيط: (فرق) 2/685.
[2] الناموس: استخدام تركي بمعنى الشرف والعزة.
([3]) من هذه الأحاديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال:" إن أدنى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه" صحيح مسلم 1/195
90. صفحة
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾
وجه النظم:
أنه كما يعطف المفرد على المفرد للاشتراك في الحكم، والجملة على الجملة للاتحاد في المقصد؛ كذلك قد تعطف القصة على القصة للتناسب في الغرض، ومن الخير عطف قصة المنافقين على الكافرين، أي: عطف ملخص ثنتى عشرة آية على مآل آيتين؛ إذ لما افتتح التنزيل بثناء ذلك الكتاب فاستتبع ثمرات ثنائه من مدح المؤمنين فاستردف ذم أضدادهم بسر: إنما تعرف الأشياء بأضدادها، ولتتم حكمة الإرشاد ناسب تعقيب المنافقين تكميلا للأقسام.
إن قلت: لِمَ أَوْجَزَ في حقِّ الكافرين كفرًا محضا بآيتين، وأطنب في النفاق باثنتى عشرة آية؟!
قيل لك: لنكات؛
منها: أن العدو إذا لم يُعرف كان أضر، وإذا كان مُخَنَّسًا كان أخبث، وإذا كان كذابا كان أشد فسادًا، وإذا كان داخليا كان أعظم ضررًا؛ إذ الداخلي يفتت الصلابة، ويشتت القوة بخلاف الخارجي، فإنه يتسبب في تشدد الصلابة العصبية، فأسفا إن جناية النفاق على الإسلام عظيمة جدًّا وما هذه المشوشية([1]) إلا منه، ولهذا أكثر القرآن من التشنيع عليهم.
ومنها: أن المنافق لاختلاطه بالمؤمنين يستأنس شيئا فشيئًا ويألف بالإيمان قليلا قليلا، ويستعد لأن يتنفر عن حال نفسه بسبب تقبيح أعماله، وتشنيع حركاته فتتقطر كلمة التوحيد من لسانه إلى قلبه.
([1]) التشويش : التخليط، وهو من كلام المولدين وأصله التهويش، كما ذكر السيوطي في المزهر1/306.
91. صفحة
ومنها: أن المنافق يزيد على الكفر جنايات أخرى كالاستهزاء والخداع والتدليس والحيلة والكذب والرياء.
ومنها: أن المنافق في الأغلب يكون من أهل الكتاب ومن أهل الجربزة الوهمية فيكون حيّالا دسّاسًا ذا ذكاء شيطانيّ، فالإطناب في حقه أعرق في البلاغة.
أما تحليل كلمات هذه الآية؛ فاعلم أن ﴿مِنَ النَّاسِ﴾ خبر مقدم لـ (مَن) على وجه([1]).
إن قلت: كون المنافق إنسانا بديهيٌّ؟
قيل لك: إذا كان الحكم بديهيًا يكون الغرض واحدًا من لوازمه وهنا هو التعجيب، كأنه يقول كون المنافق الرذيل إنسانًا عجيب؛ إذ الإنسان مكرّم، ليس من شأنه أن يتنزل إلى هذه الدركة من الخسة.
إن قلت: فَلِمَ قدّم؟
قيل لك: من شأن إنشاء التعجب الصدارة، وليتمركز النظر على صفة المبتدأ التي هي مناط الغرض، وإلا لانتظر ومرّ إلى الخبر.
ثم إن عنوان ﴿النَّاسِ﴾ يترشح منه لطائف:
منها: أنه لم يفضحهم بالتعيين، بل سترهم تحت عنوان ﴿النَّاسِ﴾ إيماء إلى أن سترهم وعدم كشف الحجاب عن وجوههم القبيحة أنسب بسياسة النبيّ عليه السلام؛ إذ لو فضحهم بالتشخيص لتوسوس المؤمنون؛ إذ لا يُؤْمَن من دسائس النفس، والوسوسة تنجر إلى الخوف، والخوف إلى الرياء، والرياء إلى النفاق، ولأنه لو شنّعهم بالتعيين لقيل إن النبي عليهِ السلام متردد لا يثق بأتباعه، ولأن بعضا من الفساد لو بقي تحت الحجاب لانطفأ شيئًا فشيئًا، واجتهد صاحبُه في إخفائه، ولو رُفع الحجاب -فبناءً على ما قيل "إذا لمْ تسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شئت"([2])- لَيقول فليكن ما كان، ويأخذ في النشر ولا يبالي.
([1]) انظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/187، والتبيان في إعراب القرآن: 1/24 ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب: 1/77. ([2]) حديث نبوي رواه البخاري عن أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن مما أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، انظر: صحيح البخاري3/1284، حديث رقم: 3296.
92. صفحة
ومنها: أن التعبير بـ ﴿النَّاسِ﴾ يشير إلى أنه مع قطع النظر عن سائر الصفات المنافية للنفاق فأعمّ الصفات أعني: الإنسانية أيضًا منافية له؛ إذ الإنسان مكرم ليس من شأنه هذه الرَّذالة([1]).
ومنها: أنه رمز إلى أن النفاق لا يَختص بطائفة ولا طبقة، بل يوجد في نوع الإنسان أية طائفة كانت.
ومنها: أنه يُلَوِّح بأن النفاق يخلّ بحيثية كل من كان إنسانًا، فلابد أن يتحرك غضب الكل عليه، ويتوجه الكل إلى تحديده، لئلا ينتشر ذلك السمّ؛ كما يخلّ بناموس طائفة، ويهيِّج غضبهم شناعةُ فرد منهم.
وأما ﴿مَنْ يَقُولُ آمَنَّا﴾؛
فإن قلت: لِمَ أفرد ﴿يَقُولُ﴾ وجمع ﴿آمَنَّا﴾ مع أن المرجع واحد؟
قيل لك: فيه إشارة إلى لطافة ظريفة هي:
إظهار أن المتكلم مع الغير متكلم وحده فـ ﴿يَقُولُ﴾: للتلفظ وحده، و﴿آمَنَّا﴾ لأنه مع الغير في الحكم.
ثم إن هذا حكاية عن دعواهم، ففي صورة الحكاية إشارة إلى ردِّ المحكيّ بوجهين، كما أن في المحكيّ إشارة إلى قوته بجهتين؛ إذ ﴿يَقُولُ﴾ يرمز بمادته إلى أن قولهم ليس عن اعتقاد وفعل، بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبصيغته يومئ إلى أن سبب استمرار مدافعتهم وادعائهم مراآة الناس لا محرك وجداني، وفي الدعوى إيماء منهم بصيغة الماضي إلى: "إنّا معاشر أهل الكتاب قد آمنا قبل فكيف لا نؤمن الآن"، وفي لفظ "نا" رمز منهم إلى: "إنا جماعة متحزبون لسنا كفرد يَكذِب، أو يُكذَّب".
وأما ﴿بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾؛
فاعلم أن للتنزيل أن يأخذ المحكيّ بعينه، أو يتصرف فيه بأخذ مآله، أو تلخيص عبارته.
([1])الرذالة: ما انتقي جيده وبقي رديئه، انظر: لسان العرب (ر - ذ - ل) 11/281.
93. صفحة
فعلى الأول؛ ذكروا الأول والآخر من أركان الإيمان إظهارًا للتقوى، ولما هو أقرب لأن يُقبَل منهم، وأشاروا إلى سلسلة الأركان بتكرار الباء مع القرب.
وعلى الثاني؛ بأن يكون كلامه تعالى؛ ففي ذكر القطبين فقط إشارة إلى أن أقوى ما يدّعونه أيضًا ليس بإيمان؛ إذ ليس إيمانهم بهما على وجههما، وكرر "الباء" للتفاوت؛ إذ الإيمان بالله إيمان بوجوده ووحدته، وباليوم الآخر بحقيته ومجيئه كما مرّ.
وأما ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾؛
فإن قلت: لِمَ لم يقل "وما آمنوا" الأشبه بـ ﴿آمَنَّا﴾؟
قيل لك: لئلا يُتوهم التناقض صورةً([1])، ولئلا يرجع التكذيب إلى نفس ﴿آمَنَّا﴾ الظاهر إنشائيته المانعة من التكذيب، بل ليرجع النفي والتكذيب إلى الجملة الضمنية المستفادة من ﴿آمَنَّا﴾، وهي "فنحن مؤمنون"، وأيضًا ليدل باسمية الجملة على دوام نفي الإيمان عنهم.
إن قلت: لِمَ لا يدل على نفي الدوام مع أن ﴿مَا﴾ مقدم؟
قيل لك: إن النفي معنى الحرف الكثيف، والدوام معنى الهيئة الخفيفة، فالنفي أغمس وأقرب إلى الحكم.
إن قلت: ما نكتة([2]) الباء على خبر ما؟
قيل لك: ليدل على أنهم ليسوا ذواتًا أهلا للإيمان وإن آمنوا صورة؛ إذ فرقٌ بين "ما زيد سخيا" و"ما زيد بسخي"؛ إذ الأول: لهوائية الذات، معناه: زيد لا يسخو بالفعل وإن كان أهلا ومن نوع الكرماء، وأما الثاني: فمعناه زيد ليس بذاتٍ قابل للسماحة، وليس من نوع الأسخياء، وإن أحسن بالفعل.
([1]) أي بين "آمنا" التى جاءت في الآية، وبين "وما آمنوا" المذكورة في السؤال. ([2]) نكتة في غاية الدقة. (المؤلف)